الزميلةالكريمة bermareme 
أتمنى ان توفقي ببحثك الحالي وان تستفيدي قدر الامكان في جمع المعلومات النظرية حوله
دعينا اولا نجمع الجانب النظري حول البحث لأن الجانب العملي والفرضيات وكل مايتعلق بالتطبيق تشتق من الجانب النظري . 

اولا : ,« النظرية السوسيولوجية في التربية عند بيير بورديو نقد و امتداد 
إعداد: بنشريف مولاي إدريس
إشراف: عثمان أشقرا
ملخص البحث
يتناول موضوع بحثنا هذا ,« النظرية السوسيولوجية في التربية عند بيير بورديو نقد و امتداد», تحليلا و مناقشة بوضعها ضمن السياق العام للمشروع الفكري لبيير بورديو, أي سوسيولوجيا الكشف على الهيمنة, وذلك وفق الخطوات التالية:
- تحديد الجهاز المفاهيمي المعتمد في هذه النظرية: الحقل,الآبتوس, الرأسمال.-
- الوقوف على تفنيد الباحث لمسلمة تكافؤ الفرص بالمؤسسة التعليمية( ديمقراطية -المدرسة) بناءا على مقولتي الإرث الثقافي و إيديولوجية الموهبة.
- استنتاج مفاده أن المدرسة تعيد إنتاج التراتبات الاجتماعية عن طريق إضفاء الشرعية عليها وإظهارها بصفة الطبيعي و البديهي.
إبراز حدود النظرية, من خلال عرض مقتضب لأهم الانتقادات الموجهة إليها مع كل من بودون و إستابلي و بودلو في فرنسا وبيكر و بلو و دونكان في الولايات المتحدة الأمريكية.
استحضار بعض الباحثين المغاربة, في محاولة تحليل و تفسير علاقة الأصل الاجتماعي للمتمدرسين بمسارهم الدراسي, و التي توصلت إلى قوة المتغير السوسيوثقافي لتحديد مسيرتهم الدراسية.
* دواعي اختيار موضوع البحث:
1. الحيز الهام الذي شغلته المسألة التربوية من أعمال بورديو.
2. كونها إحدى كلاسيكيات سوسيولوجيا التربية التي تستدعي الوقوف عندها تحليلا ومناقشة.
3. النقاشات التي خلفتها في محيطها وخارجه.
4. تجنب الانحشار داخل الأنسقة النهائية، تمشيا مع روح الفكر العلمي الذي يقضي بأن قيمة نظرية علمية تعود إلى مدى قابليتها للتفنيد
5. إبراز أهمية العوامل السوسيوثقافية في سير العملية التعليمية.
*فرضيات البحث:
لقد تناولنا في هذا البحث فرضية أساسية تتمحور حول العلاقة بين الرأسمال الثقافي و النجاح الدراسي, و الكشف عن آليات اشتغالها في المؤسسة التعليمية من خلال نظرية الإرث الثقافي و إعادة الإنتاج الاجتماعي.
*منهجية البحث:
ارتأينا و لأسباب موضوعية ذات صلة بطبيعة موضوع الدراسة أن نقتصر على المنهج التحليلي النقدي , فلم يكن من الممكن أن نعتمد منهجا غيره, إذ قمنا بتحليل نظرية إعادة الإنتاج, انطلاق من مسلماتها و فرضياتها و مفاهيمها و نتائجها, و انتقادها باستحضار مواقف معارضة لها.
*خلاصات البحث:
في مجرى هذا البحث، توصلنا إلى النتائج الآتية:
1. يؤثر المتغير الاجتماعي في المسار الدراسي بطريقة خفية وغير مرئية، لا بكيفية ميكانيكية ومكشوفة.
2. محاولة كل باحث تحليل وتفسير مسألة تكافؤ الفرص انطلاقا من نسقه الفكري العام ومرجعيته الفلسفية والإيديولوجية. حيث ينقسم الخطاب الاجتماعي حول المدرسة إلى توجهين كبيرين: الأول ماكروسوسيولوجي يعتبر المتعلم نتاج بنية سوسيوثقافية تتحكم في مساراته الدراسية والمهنية، والثاني ميكروسوسيولوجي يعطي الفرد إمكانية تعديل وتكييف قدراته وتغييرها حسب استراتيجياته الخاصة وبالتالي فإن المتمدرس يتحمل مسؤولية خياراته وتبعاتها (الإخفاق/النجاح).
3. قيام الخطابات الاجتماعية حول التربية على الربط الوثيق بين المسار الدراسي والأصل الاجتماعي، لكنها تختلف حول ترجيح متغير على آخر(الثقافي، اللساني، الاقتصادي...)، الشيء الذي يترتب عنه مراعاة الخصوصية الثقافية لكل مجتمع والظرفية الزمنية عند مقاربة مسألة ديمقراطية المدرسة.
4. تركيز هذه البحوث ولاسيما في فترة الستينات والسبعينات على دراسة المدرسة من الخارج وغياب اختراقها من الداخل (تفاعلات التلاميذ، مضامين المقررات، ..).
موقع نساء سوريا
http://www.nesasy.org/content/view/1008/285/
قبل ايراد شرح النظريات أرجو منك زيارة هذا الموقع والرابط أعلاه لنو يحتوي على دراسات حول النظريات الاجتماعية ومن ضمنه 6 صفحات أنا زودتك فقط بأول صفحة أعتقد ...
أقسام المادة
الموجز في النظريات الاجتماعية التقليدية والمعاصرة
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 1 من 6
الجزء الأول
مقدمة
ليست النظرية من كماليات البحث العلمي بقدر ما هي ضرورة ملحة للباحث الاجتماعي، لذا فالدعوة إلى التخلي عنها أو التقليل من أهميتها يجب مواجهتها بالرفض التام حتى لا يُحرَم الباحث من الأرضية الرئيسية لتأسيس علمه، إذ أنه بدون نظرية تمثل رصيدا لأي علم فلا وجود لأي أساس للعلم. إذن أهمية النظرية تكمن في أننا نقرأها لا لنفهمها ونطورها فحسب بل لأن النظرية تمثل نمطا لبناء المعرفة العلمية وضرورة لكل ملاحظاتنا، إنها الشرط الضروري لانطلاق التفسير والتحليل حتى وإن كانت غير كافية حينا لإحداث قطيعة تامة مع التفسيرات غير العلمية. فلماذا الاهتمام بالنظرية؟
يرى العلماء أن التقدم العلمي لا يمكن أن يتم إلا إذا أُنجز على مستوى نظري، بيد أن المعرفة العلمية ليست مجرد تراكم للمعارف، ذلك أن صياغة النظريات العلمية وتصوراتها وتنظيماتها إنما تتحكم فيها مجموعة من الفرضيات والمفاهيم التي يسميها،، توماس كوهين ( Thomas Kuhn )في كتابه الشهير عن " بنية الثورات العلمية "،، بـ " الشكل التحليلي " ؛ هذا المفهوم الذي لم تحظ ترجمته بالرضى لدى الباحثين العرب. وفي واقع الأمر فإن التقدم في البحث العلمي والتنظير ليس مسالة متوازية المسير بل متلازمة. فالتقدم العلمي لا يتمثل بمجرد تجميع للحقائق فحسب بل هو عملية تبرز في التغيير النوعي في بنية الأنساق النظرية. فإذا كان هدفنا هو الوصول إلى خلاصات هامة تتجاوز ما هو متعارف عليه فلا يمكن تحقيق ذلك من الاعتماد على الجانب الامبريقي دون ضبط للجانب التنظيري وإلا باتت بنية الأنساق النظرية جامدة وفقيرة مثلما هو الحال في علم الاجتماع الأمريكي الذي يفتقد إلى الأسس النظرية في تفسير الظواهر الاجتماعية أو الربط بين خيوط الظاهرة.
يشير عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز ( T.Parsons ) إلى النظرية من حيث وظيفتها أيضا في البحث العلمي: " فالنظرية لا تصبح فقط ما نعرفه ولكنها تقول لنا أيضا ما نود معرفته، أي أنها تمدنا بالأسئلة التي تبحث لها عن الإجابة ". إذن النظرية لها قدرة فسيحة على التعامل مع الأشياء.
لو انطلقنا من بناء البحث العلمي لاستطعنا القول أنه ينطلق من جملة من المعلومات التي تتخللها إشكاليات ما وتتجه إلى صياغة ابستيمولوجية ( معرفية ) للمشكلات المثارة، ومن هذه المشكلات ننتقل بعد ذلك إلى رصيد من الفرضيات التي تكوِّن القاعدة لكل عملية تنظير. ومن الواضح أن الوصول إلى مرحلة التنظير مسألة تستدعي المرور بعدة مراحل، فالبحث العلمي ما بين المعطيات الامبيريقية والسير نحو التنظير لا بد له من التوقف عند اقتراح الفرضيات العلمية مقابل استبعاد الفرضيات غير العلمية حتى يتسنى له الاقتراب من الاشكاليات.
ولكن ما أن نصل إلى النظرية حتى نكون أمام جدول متناسق من الحقائق المعروفة، وبهذا المحتوى والوضوح للنظرية نستطيع أن نتبيَّن كيف تم تنظيم وبناء تلك الحقائق، كما أن النظرية تفسر هذا البناء المعرفي وتمدنا بنقاط مرجعية تسهل علينا الانطلاق في البحث عن بنىً معرفية جديدة وحقائق جديدة.
في هذه الوثيقة المرجعية التي تتكون من جزأين سوف نتحدث عن بعض من أشهر رواد النظرية الاجتماعية بشقيها التقليدي والحديث، فما هي النظرية الاجتماعية؟
- بصفة عامة يمكن القول أن النظرية السوسيولوجية هي كل محاولة فكرية تفسر جانبا من الحياة الاجتماعية، فالنظرية السوسيولوجية في هذا الجانب يمكن اعتبارها امتدادا لما يسمى بالفكر الاجتماعي الذي ترجع جذوره إلى المفكرين والفلاسفة القدماء. وعندما نتساءل عن النظرية السوسيولوجية فالشيئ الذي يميزها عن المفاهيم هو أنها قادرة على أن توفر لنا نوعا من التفسير لملمح من ملامح الحياة الاجتماعية أو ظاهرة من الظواهر.
- ولكن هناك رؤية مختلفة، إذ يرى البعض أن النظرية الاجتماعية ليست سوى مجموعة من الفرضيات القادرة على الصمود في ساحة البحث الاجتماعي الميداني. وبمعنى من المعاني فالنظرية ليست إطارا نظريا يساعد على التفسير إنما يمكن تطبيقها على الساحة والحياة الاجتماعية، وبالتالي فهي عبارة عن مجرد فرضية مُعَدَّةٌ للاختبار.
- وفعليا ثمة الكثير من النظريات المعاصرة في علم الاجتماع ليست أكثر من مجموعة أفكار غير متماسكة، أي أنها ليست مجموعة منظمة من الفرضيات التي يمكن اختبارها.
- بهذا المعنى الذي يتحدث عن النظرية الاجتماعية بوصفها تفسيرية لأحد مناحي الحياة الاجتماعية أو مجرد فرضية قابلة للاختبار ميدانيا لن يكون أمامنا إلا التسليم بغياب النظرية الاجتماعية، وما النظريات الشائعة إلا مجموعة من الأفكار لم تصل بعد إلى مستوى النظرية.
- أخيرا فإذا كانت النظرية بوصفها حصيلة لتعميم يستوحيه الباحث الاجتماعي من حقائق معروفة تمثل بطريقة حاسمة وكاملة قدر الامكان مجموعة من القوانين والفرضيات المختبرة إمبيريقيا فإن أحسن النظريات السوسيولوجية هي تلك التي تمدنا بأحسن أداة للتعامل مع واقع اجتماعي معين.
وفي علم الاجتماع المعاصر ثمة نوعين من النظريات:
- النظريات الكبرى، ومثالها النظرية الماركسية ذات الطرح الشمولي أو التحليل الماكرو سوسيولوجي.
- ولكن هناك تصنيفات أخرى للنظرية الاجتماعية على أساس نظريات البنية ( النظريات البنيوية الأنثروبولوجية والاجتماعية ) أو نظريات الفعل كالنظرية التفهمية لـ ماكس فيبر.
الجزء الأول:
النظرية الاجتماعية التقليدية
الوضعية 1 -
سان سيمون S. Simon
( 1825 - 1760 )
المقاربة الوضعية هي منهجية تحليله تقوم على استبعاد لأنماط الفكر والتحليل اللاهوتي ( الديني ) والميتافزيقي ( التجريدي = الطبيعة ) من أي تحليل مقترحة بديلا عنهما الإنسان الذي بات يتمتع بقيمة مركزية في الكون، بهذا المضمون سنكون على إطلالة لمعادلة جديدة تحكم سير الحياة الاجتماعية برمتها على النحو التالي:
الظاهرة الظاهرة الظاهرة
مرجع لاهوتي مرجع ميتافزيقي مرجع إنساني / الوضعية
الدين الطبيعة = التجريد العقل
هذه المعادلة التي ستمثل لدى أوجست كونت المراحل التي مرت به الإنسانية ومصدر قانون الحالات الثلاث تبين لنا أن الإنسان لم يكن موضع ترحيب في المرحلتين السابقتين , إذ أن الإنسان عجز عن أن يجد له موقع او مكانة فيما مضى لذا فقد استبعد من أي تحليل للظواهر مفسحا المجال أمام القوى الدينية أو قو ى الطبيعة. وبما انه لم يكن للإنسان أية قيمة فلم تكن أيضا للمجتمع آية قيمة, ولهذا تطورت الوضعية العلمية التي تناولت ظواهر طبيعية بينما لم تتطور ذات الوضعية حينما كانت تتناول ظواهر متعلقة بالإنسان والمجتمع , وسنرى كيف وضع أوجست كونت حدا لهذه الازدواجية في التفكير والتي يسميها الفوضى العقلية التي تسببت في ثلاث ثورات برجوازية وقعت في أعقاب الثورة الفرنسية 1789 حتى سنة 1848، ولكن قبل الوصول إلى أوجست كونت علينا العودة الي جذور الوضعية لدى أستاذ كونت وهو المفكر سان سيمون.
عاش سان سيمون في نظام إقطاعي سليلا لأسرة أرستقراطية، ويحمل لقبا اجتماعيا هو الكونت وكان ضابطا برتبة ملازم أول لما كانت فرنسا تخوض حربا ضد الإنجليز في شمال القارة الامريكية، وقد نضج فكره حلال الثورة الفرنسية التي كانت بمثابة ثورة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في أوروبا عامة وفرنسا خاصة وثورة على النظام المعرفي التقليدي السائد في فرنسا وثورة على النظام السياسي الملكي.
بداية المقاربة الوضعية:
بدأت المقاربة الوضعية في مرحلة الفكر الموسوعي الذي عرفه في القرن 18 واتخذت عند سان سيمون طابعا تطبيقيا عمليا وليس نظريا مثلما كان سائدا في المرحلة التجريدية أي العلم النظري المجرد، ففي القرن 18 طور الفكر الموسوعي آليات تحليل جديدة تقوم على الترابط بين المعرفة والواقع الإنساني لذا سيمثل هذا الفكر مرجعية سان سيمون. فمن أين البداية إن لم تكن من المقاربة الوضعية للدين؟
أ. تعريف سان سيمون للدين:
في كتابة الشهير ( المسيحية الجديدة ) يعرف الدين بأنه:
"جملة تطبيقات العلم العام التي يمكن بواسطتها أن يحكم الرجال المستنيرون غيرهم من الجهلة ".
بهذا المضمون فان الديانة عند سان سيمون هي أداة مدنية للحكم المستنير لغير المستنيرين. وبما أن الدين يلعب دورا في التربية لذا فان التربية هي العنصر الذي يساعد على توطيد المشاعر الديموقراطية وتحقيق القيم الأساسية.
مفهومي " السياسة " و " الديموقراطية = الحرية "
· السياسة هي علم الانتاج.
· الحرية هي نبذ الميز العرقي والثقافي والسياسي.
فما الذي يحدث عندما يلتقي المفهومان؟ سنلاحظ تغييرا في مفهوم الأمة. وإذا أعطينا هذين المفهومين مدلولا وضعيا وتصورا موضوعيا ( أي محاكمة المفهومين وتحليلهما علميا وليس دينيا ولا تجريديا ). فالذي سيحدث أن أمة جديدة ستنبثق.هذه الأمة متحررة من الميز الديني والانغلاق مثلما ستكون متحررة من تبعات الإقطاعية. ومثل هذه الامة الجديدة يسميها سان سيمون بـ " الأمة العاملة ".
استنتاج أولى:
من الملاحظ أن تغير القاعدة المعرفية تسبب في تغير النتائج. فلو نظرنا إلى المفهومين في المراحل السابقة على الوضعية فلا يمكن الحديث عن أمة عاملة بالمعنى السان سيموني لان السياسة كانت حكرا على طبقة معينة ولان المجتمع ليس حرا ولا يتمتع بأية عدالة , ومثل هذه السياسة والعبودية كانتا تجدان لهما شرعية ذات طابع ديني او طبيعي. بيد أن الوضعية بوصفها استعمال للعقل ورفع من مكانة الإنسان قدمت السياسة كأداة حيوية في تنشيط الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونقلت الأمة من طور الخمول والكسل الي طور العقل والإنتاج ووضعت الجميع على قدم المساواة واصبح الإنسان سيد نفسه حرا من ا ي تمييز عرقي او ثقافي او سياسي.
هكذا فالانتقال من المرحلة الإقطاعية اللاهوتية الى المرحلة الصناعية العلمية هو انتقال من ساحة العلم النظري الي ساحة العلم التطبيقي العملي. فالوضعية تأبى الاعتراف بفواصل مابين النظري والعملي إذ ثمة ترابط بين المعرفة والواقع الا نساني.
المواطنة والعدالة الاجتماعية:
يربط سان سيمون بين مفهوم المواطنة الذي جلبه معه من أمريكا حيث كان يقاتل الجيش الإنجليزي في بلد تعج فيه الثورات الأهلية الكبرى والعارمة وبين العدالة الاجتماعية بل انه ينحاز الى مفهوم المواطنة معلنا في كتابه ( المسيحية الجديدة ) تخليه عن لقبه الكونت:
[ لم يعد ثمة أسياد.نحن جميعا متساوون.وأعلمكم بهذه المناسبة أنني أتخلى عن صفتي الكونت التي اعتبرها وضعية جدا أمام صفتي كمواطن..]
تبع هذا الإعلان حسما لتردد سان سيمون في تأييده للثورة الفرنسية في البداية ثم نال لقب المواطن الصالح مرتين متتاليتين مما يعني انه بات رمزا للتحرر والمساواة والتجديد. هذه النقلة في حياة سان سيمون – المواطن الصالح – ليست نقلة سياسية فحسب بل نقلة اجتماعية وفي هذا الأساس نقلة فكرية ومعرفية في ذات الوقت. كما أن هذه النقلة أيضا جهد سان سيمون في ترجمتها من خلال عمله الدؤوب من اجل تغير مضمون المسيحية من الداخل وإكسابها مضمونا جديدا علميا يقوم على مبدأ الحرية والمساواة. هكذا يبدو الدين هو العلم العام كما يصرح سان سيمون.
عودة إلى مفهوم الدين:
إذن الدين ليس حالة ثابتة بقدر ما هو حالة تطورية ولما يتساءل عن الدين وماهية الأديان نراه في كتاب ( المسيحية الجديدة ) يقول بتطورية الأديان وعدم بقائها على حالها.
[ الأديان مثلها مثل بقية المؤسسات تتمتع بطفولة وفترة قوة ونشاط وأيضا مرحلة انهيار وحين تكون في مرحله انهيار فأنها تكون ضارة ,أما في مرحلة الطفولة فهي غير كافية..]
ب. قراءة في المقاربة الوضعية للأديان عند سان سيمون:
السؤال: لماذا ينظر الكثير إلى سان سيمون على انه من مؤسسي علم الاجتماع الديني؟
لانه في واقع الأمر ساهم ولو بشكل محدود في تأسيس هذا العلم. ومن حيث الجوهر لان سان سيمون قدم الأديان بوصفها ظواهر اجتماعية وإنسانية من الممكن تحلياها تحليلا علميا كبقية الظواهر الأخرى. بل أن سان سيمون قاربها كما فعل ابن خلدون في نظريته حول تداول الحضارات التي تنشأ ثم تقوى ثم تنهار, وهكذا بدا له الدين. إذن الوضعية تخلصت من كل الثوابت المقدسة.
ت. ما هو الدور الذي تلعبه الفلسفة الوضعية؟
يلاحظ أن الوضعية الجديدة كما مارسها سان سيمون لا تهدف فقط الى تغيير شروط إنتاج المعرفة بل الى تغيير النظام السياسي والمؤسساتي والاقتصادي. بمعنى أن الوضعية تمثل نقلة جذرية في النظام السياسي والاجتماعي القائم. وما لم تحدث هذه النقلة فمن المستحيل أن نتحدث عن أمة عاملة.
إذن ثمة تغييرات تجعل من المجتمع عنصرا إيجابيا.
والسؤال هو: ما هي مستويات التغيير الجديد بحسب المقاربة الوضعية؟
أولا: تحقيق العدالة في مضمونها السياسي والاجتماعي واستبعاد الدين من الحياة الاجتماعية ثمة مبدأ يحكم تحقيق العدالة المنشودة ذو بعد شخصي وعلمي لدى سان سيمون. هذا المبدأ هو وجوب جبر الهوة الفاصلة بين النظري والتطبيقي للوصول الى علاقة تكاملية بين المستويين، ودون ذلك سيظل هناك ازدواجية تحافظ على استمرارية الهوة الفاصلة لذا لابد من إنجاز منظومة ابستمولوجية ومعرفية جديدة تقوم على التكامل بين البعدين النظري والتطبيقي ولعل أوضح مثال هو ما طبقه سان سيمون على نفسه تعلق في دعوته إلى تحقيق العدالة تخليه عن لقب الكونت وإعلائه لشأن المواطنة ( لم يعد بيننا أسياد…).
هذه المقاربة الوضعية الباحثة عن العدالة السياسية والاجتماعية ستسعى عمليا الى:
· هدم العناصر السياسية والمؤسسية المكونة للنظام السياسي والاجتماعي القديم والتي من بينها التميزات الطبقية والاجتماعية والمسيحية في شكلها التقليدي · لذا فان سان سيمون سيرسي دعائم تعامل معرفي جديد مع الظاهرة الدينية بمختلف تنظيماتها ومؤسساتها، تعامل يقوم على اعتبار الظاهرة الدينية ظاهرة اجتماعية إنسانية من خلال إخراجها من دائرتها المقدسة والنظر إليها باعتبارها ظاهرة إنسا نية، هذا المبدأ المعرفي الجديد تجاه الظاهرة الدينية سنجده حاضرا وقائما في كتابات الكثير من العلماء مثل غاستون لبلوس G.lebles و هنري و دوركايم و مارسيل موس , هذه الأسماء بالإضافة الى ماكس فيبر سيكونون أهم المتخصصين في علم الاجتماع الديني مستنيرين باطروحات سان سيمون ومفهومه للدين ومنهج التعامل معه.
ولكن لماذا يجهد سان سيمون لاستبعاد الدين من الحياة الاجتماعية ويشدد على تشجيع التعامل الجماعي بين أفراد المجتمع؟ ثم لماذا تنقل سان سيمون بين الكنائس مبشرا بالمسيحية الجديدة؟
مجتمع سان سيمون
إن مجتمع سان سيمون هو مجتمع صناعي علمي , ومثل هذا المجتمع يبحث عن دماء جديدة لضخها في عروقه كما انه يحتاج الى وحدة معرفية ومعيارية وبالتالي لابد من القضاء على مخلفات النظام القديم بكل منظوماته وتشكيلاته ومعتقداته وتصوراته وبناه وأنماط تفكيره وتحليله إذا ما أردنا تحقيق العدالة والتقدم فكيف العمل؟ وما العلاقة بين الدين والمجتمع الجديد؟
يحرص سان سيمون على تجاوز الدين اعتقادا منه انه العقبة التي تشجع الفراغ. ولانه ثمة تناقض بين الفراغ والعمل الجماعي المنتج لذا ينبغي أن نغير مضمون الدين بان نكسبه مضمونا جديدا يتمثل في نظام بشري جديد. ولان الإنتاج الجماعي او الخلق الجماعي تحديدا يقوم على الانتاج البشري، لذا ينبغي فك التناقضات التي يعاني منها مجتمع ما بعد الثورة – أي المجتمع الصناعي – إذ يلاحظ سان سيمون أن المجتمع ما زال في حالة صراع قائم على:
· معرفة لاهوتية ومعرفة علمية.
· سلطة إقطاعية وسلطة صناعية.
إذن ثمة تحالف بين المعرفة اللاهوتية والسلطة الإقطاعية ضد المعرفة العلمية والسلطة الصناعية ولفك هذا التناقض أو التحالف ينبغي استبعاد الدين للسماح بمرور العمل الجماعي المنتج وقتل الفراغ.
ثانيا: تشجيع العمل والإنتاج
إن التغيير الجديد التي تريد إرساءه المقاربة الوضعية يقوم أساسا على العمل والإنتاج كيف ذلك؟
بانتشار الأفكار الوضعية بفعل انتشار الصناعة.
إذ يعتقد سان سيمون أن انتشار الأفكار الوضعية ستساعد وستشجع على انتشار الصناعة التي هي الشرط الأساسي والوحيد لقيام مجتمع وضعي ومعرفة وضعية، فالصناعة بطبيعتها تخلق مجتمعا وضعيا وتصورات وضعية في نفس الوقت استنادا الي مبدأ يعتبر أنالمعرفة العملية تعني المعرفة العلمية. إذن الصناعة هي مبدأ مركزي في كل النظريات المعرفية،هذا المبدأ نجده لدى الفكر الاشتراكي الطوباوي الذي يشمل ويعبر عنه سان سيمون و قودوين و بودون.إذ أن الفكر الاشتراكي الذي يعد سان سيمون عميده بني على مركزية مبدأ الصناعة. بمعنى أن الصناعة تشجع بطبيعتها على خلق القيم الوضعية المستقلة عن الفكر الديني والكنسي في نفس الوقت. كما نجد مركزية مبدأ الصناعة عند دوركايم من خلال كتابيه " تقسيم العمل الاجتماعي "و" الانتحار " وكذا مع ماكس فيبر في كتابه " الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية ".
قيمة الصناعة ومكانتها:
إذن الصناعة في الفكر السياسي والاجتماعي الغربي عامة والفرنسي خاصة هي شرط كل التحولات النوعية والفكرية والاجتماعية.
مثال 1: العقلانية كما عبر عنها ماكس فيبر هي قيمة بيروقراطية وصناعية قبل كل شيئ فالمجتمع الذي لا يملك بيروقراطية و أبنية صناعية لا يمكن ولا يحق له أن يدعي العقلانية.
مثال 2: يقيم سان سيمون مقاربة بين الانتاج والكسل وأمة كسولة وأمة عاملة ويتساءل في إطار المقاربة الوضعية: هل يمكن أن يحصل تعايش بين الأمتين؟ لذا يطالب سان سيمون بالحزم مع الأمة الغير منتجة بضرورة إزاحتها ولتحل محلها الأمة المنتجة ولكن ما هي أداة التغيير؟
وفي المجتمع الإقطاعي يعود سان سيمون ليؤكد على استعمال أدوات المعرفة الوضعية والعمل على القضاء على الهوة الفاصلة بين البعد النظري والبعد التطبيقي للوصول الى وحدة المعرفة , هذا هو جوهر المقاربة الوضعية. لذا نجد سان سيمون يصر على استبدال المضمون القديم للمسيحية بمضمون جديد يعمل على تطويرها من الداخل، هذا المضمون الجديد يتمثل في كتابه " النظام الصناعي " من خلال:
· التأكيد على سعيه الى تكوين مجتمع حر.
· التأكيد على نشر المبادئ والقيم التي ستكون أرضية النظام الجديد.
· التأكيد على إن النظام الاجتماعي يستند على ثلاث فئات:
أ. الفنانون لأنهم يفهمون قيم التغير ويشكلون أداة تشجيع للمجتمع حتى يغير أوضاعه القائمة.
ب. العلماء الذين يقترحون تصورات وبدائل ووسائل عامة يمكن استعمالها لتحسين حال الأغلبية.
ت. الصناعيون الذين يشجعون المجتمع على القبول بالمؤسسات الجديدة.
أما منطق الترتيب أعلاه فهو التقاء الإلهام مع التفكير ومع الإبداع والمهم في هذا التصنيف أن الصناعيين يتربعون على قمة المجتمع الصناعي وفي أعلى مراتب النظام الاجتماعي الجديد. ولنقرأ أهميه المقولة التالية لـ سان سيمون:
[ لو حدثت في ليلة صماء فاجعة مفاجئة ذهبت بأكثر الشخصيات الكبرى من الأسرة المالكة والوزراء وكبار القضاة…وسواهم ممن هم في هذه الطبقة , فان الشعب الفرنسي سيبكيهم حتما لانه شعب حساس , ولكن هذه الفاجعة لا تبدل شيئا مهما أو تغير تغييرا ذا اثر في أعماق الشعب , أما لو ذهبت هذه الفاجعة برؤوس العلماء والصناعيين وأرباب المصارف والبنوك … فان خسارة المجتمع فيهم كبيرة جدا لان مثل هؤلاء لا يمكن تعويضهم بسهولة !!] ( راجع: تاريخ السوسيولوجيا / غاستون بول ).
استنتاجات
أ.) في مجتمع العدالة والمساواة، هو المجتمع الحر الذي يقوم على حركة جمعانية أي مجموعة من المواقف لم يعد الفرد فيه خاضعا
· هذا المجتمع أُخرج الفرد من مرحلة الفكرة ليصبح مواطنا. وهذه نقلة سياسية واجتماعية.
· أشرك الفرد مع الآخرين ( المجتمع ) في عمل جماعي واحد وإبداع واحد وخلق واحد.
هذا يعني أن الوضعية بالمضمون السان سيموني تعبر عن مردودية الفرد وليس فقط تغيرا في الأوضاع الاجتماعية والسياسية. كما يعني أن سان سيمون يراهن على دور المجموعة على التغير، هذه المجموعة التي تبنى على ثلاث مستويات وهي:
· الانتاج
· التقنية
· الصناعة
ب.) العناصر الأساسية التي اعتمدتها المقاربة الوضعية مع سان سيمون هي:
1. تحييد الدين والفكر اللاهوتي عن كل مشاركة في الحياة العملية.
2. وضع أسس مشروع علمي وفكري ومعرفي يقوم على مبدأين أساسين هما:
· مبدأ العلمية ؛ فلا تعامل بعد الآن مع الظواهر والأشياء الا من منظور علمي.
· مبدأ العلمنة وفيه تحييد وإقصاء صريح للدين.
هذه هي آليات التحليل العلمية التي ضمنها سان سيمون للمقاربة الوضعية وهي الآليات التي سنجدها مستعملة في النص الكونتي بطريقة او بأخرى. هذه أيضا هي الأرضية المعرفية والعلمية التي سينطلق منها اوجست كونت ليجعل من المقاربة الوضعية اكثر قربا من الواقع والتحليل. ومبدئيا فالمقاربة الوضعية ستجمع بين مستويين رئيسيين:
1. المستوى النظري: عبر قراءة العلوم وتنظيمها وتثبيتها وهو ما قام به سان سيمون.
2. المستوى التطبيقي: وهو تطبيق عناصر المقاربة الوضعية في تحليل واقع المجتمع.
ومن هذه الأرضية المعرفية سينطلق اوجست كونت في ترتيب بيت العلوم.
:- دور معلم اللغة الانجليزية في معالجة الضعف وتدني مستوى الطلاب
1-خلق الدافع أو الحافز (motivation): وهو أن يكون للطالب الرغبة الأكيدة لتعلم اللغة الإنجليزية من تلقاء نفسه وهذا الإحساس ينشأ مع الطالب ويكون ملازماً له داخل وخارج أسوار المدرسة. مع توفر كافة الوسائل التي تشجعه على التعلم الذاتي ، ويكاد هذا الدافع هو المؤثر والعامل الرئيسي في حياة الفرد .
أما ما يتعلق بالطالب فيكمن فيما يلي :
*-عدم اهتمام الطلاب بحفظ الكلمات الجديدة.
*-عدم إدراك كثير من الطلاب لأهمية اللغة الإنجليزية في عالمنا اليوم.
*شعور الطالب بالإحباط نتيجة لرؤيته إخوانه أو زملائه الحاصلين على مستويات تتجاوز 90% في امتحانات الثانوية العامة ولم تتسنى لهم فرصة إكمال دراساتهم الجامعية ما بعد الثانوية .
*-خوف بعض الطلاب من هذه المادة. وهذه طبيعة بعض الطلاب في بعض الأماكن ، ربما تكونت لديهم هذه الأفكار من خلال مجتمعهم أو تأثير الطلاب الكسالى عليهم . فدور المعلم هنا هو إزالة هذه الصفة السلبية وترغيبهم في المادة.
*-المفهوم الخاطئ لدى الكثير من الطلاب إذ أنهم يعتبرون مادة اللغة الإنجليزية كبقية المواد فالطالب ينسى ما درسه في الصف السابق ولا يحاول الرجوع إلى ما سبق دراسته في الأعوام المنصرمة .كما انه لا يتعامل معها كلغة تحتاج إلى ممارسة مستمرة بل كمادة تنتهي بانتهاء الامتحان.
*- تمزيق الطلاب للكتب المدرسية عقب كل اختبار نهائي وعدم الاحتفاظ بها أو العودة إليها في بعض الأحيان التي يتطلب ذلك .
*-القنوات الفضائية: وما لها من أثر سلبي في التأخر والسهر في الليل ،وبالتالي النعاس في الحصص، عدم قدرة بعض الطلاب على الانتباه والتركيز، التكاسل في أداء الواجبات المنزلية التحريرية .
ويتمثل حل مشكلة عدم رغبة الطلاب في التعلم عن طريق ما يلي :
1-على المعلم إعداد دراسة ليحتوي على مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تتناسب مع قرارات طلابه المختلفة ومراعاة الفروق الفردية .
2-تشجيع المشاركة الطلابية أثناء الحصة عن طريق إلقاء الأسئلة إعداد الصور والملصقات والوسائل التعليمية المختلفة ، وأنشطة التحدث ، والألعاب والأناشيد .
3-إشعار الطلاب بمدى تقدمه وفي حالة عدم قدرته على الجواب عدم تركه فترة طويلة واقفا بل مساعدته عن طريق أحد زملائه ثم العودة إليه لاحقا لتكرار الجواب الصحيح مع تشجيعه وإشعاره بضرورة عمل الأفضل في المرات القادمة.
4-على المعلم ألا يصحح جميع الأخطاء التي يقع فيها طلابه ، بل إتاحة الفرصة له للتحدث والإجابة وتصحيح الأخطاء الكبيرة وذات الأهمية فقط ، فمثلا عندما يقوم الطالب بالحديث في موضوع على المعلم أن يترك الطالب يتحدث وألا يحاول تصحيح الأخطاء اللغوية كلها أو تصحيح القواعد لأنه هنا في موقف تعبير عن أفكاره .
5-تقبل مقدارا مناسب من جودة الطلاقة في استخدام اللغة كما وكيفا .
6-إشعار الطالب بأهمية الاختبارات الفترية ، أهمية العمل الجماعي وعمل البحوث والتقارير في المادة والقراءة الخارجية .
7-تشجيع الطالب على استخدام اللغة في الحديث عن أي موضوع يختاره يكون قادرا على التحدث عنه وعدم إرغام الطالب على موضوع معين .
2-دور الأسرة: تعد الأسرة من العناصر الهامة التي تساهم بفاعلية في العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطالب ، فدور الأسرة لا يقتصر على توفير المطعم والملبس والرعاية فقط بل يتعداها إلى ابعد من ذلك ولكن وبكل أسف نجد أن دور الأسرة في منتهى السلبية وقد يكون ذلك ناتجاً عن جهل الأب والأم بكيفية التعامل مع أبنائهم وتهيئة الجو الملائم للاستذكار وتتجلى سلبية الدور الأسري في عدم مراقبة أبنائهم ومعرفة نتائجهم الفصلية أو عدم متابعة حل الواجبات أو نسيان الكتاب المدرسي أو من خلال توفير الوسائل المساعدة في تنمية اللغة داخل البيت عن طريق توفير الكتب والجرائد والمجلات المصورة والبرامج المساعدة في تعلم اللغة ..
3-دور المدرسة ونظام الاختبارات : ويتمثل في غياب مبدأ عقاب الطالب المهمل الأمر الذي جعل الطلاب لا يأبهون باحترام النظم والقوانين المدرسية ، خاصة في المدارس الثانوية ، حيث أن وزارة التربية ألزمت المعلم بعدم عقاب الطالب بدنياً وبالتالي تساهل كثير من الطلاب في أداء واجباتهم ، وقل إحترامهم لمعلميهم وبدوا غير مكترثين بمستقبلهم وخاصة أنهم لا يقدرون هذه اللغة أو المعلم الذي يقوم بتدريسها .كما نورد بعض الأسباب الأخرى المتمثلة فيما يلي :
*-عدد الحصص الأسبوعي في المرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية غير كاف لتغطية المادة الدراسية بصورة متقنة.
*- إكمال المعلمين في أكثر من مدرسة : عدم توفير العدد المناسب من معلمي اللغة الانجليزية في المحافظة مما يؤدي إلى ضرورة إكمال المعلم في أكثر من مدرسة وهذا يؤدي إلى تشتيت جهد المعلم وعدم قدرته على التطوير والتجديد
*-عدم وجود كتب لغة إنجليزية مبسطة كالقصص والحكايات أو المسرحيات أو الروايات القصيرة في مكتبة المدرسة أو مكتبة المنزل أو لدى الباعة في المكتبات.
*- عدم التعاون بين المنزل والمدرسة من أجل تقديم الخبرة الكافية إلى الأسرة من أجل تلافي أسباب القصور لدى هؤلاء الطلاب.
*-المبنى المدرسي والفصول غير مناسبة للعملية التعليمية ، خاصة مع عدم توافر الوسائل المساعدة في تعلم اللغة الإنجليزية كالحاسب الآلي المجهز بالبرامج المساعدة على تعلم اللغة الإنجليزية ، والأشرطة ( كاسيت أو فيديو )
*-شكل وطريقة الاختبارات الخاصة بهذه المادة التي لا تتيح المعلم الإبداع وإضافة ما يراه مناسباً وتحصره في قالب معين لا يستطيع منه فكاكاً ، فالشكل العام للاختبارات أصبح مألوفاً سنوياُ لدى الطلاب مما جعلتهم مدركين تماماً للمادة التي يمكن أن يشملها الاختبار وكيفية توزيع الأسئلة والدرجات مما شجعهم على عدم بذل أي مجهود في الاستذكار والمراجعة .
*-عندما يحصل بعض الطلاب في الفصل الأول على درجات جيدة تجعله ينصرف تماماً عن المذاكرة والمراجعة لمفردات وقواعد اللغة الهامة فكل همه أن يحصل على أعلى مستوى يمكنه من النجاح وليس تعلم اللغة وإجادتها.وبالتالي تجاوز بعض الطلاب الضعاف للاختبارات وبالتالي يقلل ذلك من عزيمة الطلاب المتفوقين الذين يبذلون مجهود كبير ومضاعف ثم يفاجئون بنجاح أولئك الكسالى ليكونوا معهم في نفس الفصل الدراسي مما يضعف مستوياتهم التحصيلية في بعض الحالات .
*السماح للطلاب الراسبون في الثانوية العامة بالعودة إلى مقاعد الدراسة ، حيث يمثل هؤلاء شريحة كبيرة من عدد الطلاب الذين تكون مستوياتهم متدنية أصلا ، وبعضهم لا يريدون طلب العلم ، وبالتالي يصرف المعلم جهداً مضاعفاً للتعامل مع هذه الفئة والأجدر أن تفتح لهم مراكز خاصة أو فصول خاصة بهم .
4-عوامل سيكولوجية: وتتمثل في الإحساس بأن اللغة الإنجليزية لغة يصعب فهمها وتحتاج لمجهود مضن . لذا فالطالب يحضر إلى المدرسة وفي ذهنه هذا الفهم الخاطئ وهنا يأتي دور المعلم لتصحيح هذا المفهوم ، ومساعدة الطلاب في كسر حاجز الصعوبة عن طريق تسهيل المادة بالطرق والوسائل التعليمية المتاحة.
5-عوامل بيئية: تتمثل في عدم تعامل أفراد المجتمع باللغة الإنجليزية جعل الطالب لا يسمعها خارج المدرسة فالطالب يحتاج للتعامل باللغة خارج المدرسة لكي يزداد اهتمامه بها ، فتعلم اللغة لا يقتصر فقط على المنهاج الدراسي وبمعدل ساعة واحدة في اليوم بل تحتاج إلى الممارسة اليومية المستمرة .
6-معلم اللغة الإنجليزية: فالمعلم هو الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية فهو المسئول عن مستويات الطلاب التحصيلية في هذه المادة، فإما أن يكون دوره إيجابياً أو سلبياً على عملية التعلم.فالمعلم يستطيع بخبرته تجاوز الكثير من الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة للعقبات التي قد تعترض طريقه سواءً كانت منهجية ، إدارية أو عقبات مصدرها الطالب. فالمعلم يشجع الطلاب ويشحذ هممهم ويحفزهم على التطور والإبداع والابتكار. ولذا تعود أسباب تدني مستويات الطلاب التحصيلية والمتعلقة بالمعلم فيما يلي :
*-إذا لم يكن المعلم صاحب شخصية قوية مدركاً لمعنى الإدارة الصفية الجيدة بحيث يقوم المعلم فيها بدراسة سلوكيات تلاميذه فيعالج كلاً بما يلائمه مع استخدام عبارات المدح والثناء على الطالب الملتزم المتزن ليلفت نظر صاحب السلوك المشاكس إلى أن يحذو حذوه لينال ما ناله من ثناء ولا ينهر الطالب ويعنفه على كل صغيرة وكبيرة ويسخر منه في كل شاردة وواردة ويهتم بالنواحي الإيجابية من سلوكياته أكثر من اهتمامه بالنواحي السلبية منها ويتميز دائماً بالعدل والذكاء والحزم والموضوعية.
*- إذا لم يكن المعلم مطلعاً باستمرار على الجديد في طرق واستراتيجيات التدريس ، فالمعلم يصبح غير ذي فائدة ويفقد قيمته في اللحظة التي يعجز فيها عن تطوير قدراته وأفكاره.
*- إذا وجد المعلم القاسي الذي يحمل طلابه على النفور منه ومن مادته فيتكون لديهم شعور بالكراهية لهذا المعلم وللمادة التي يدرسها بدلاً من الإقبال عليها ومحبتها .
*- المعلم الذي يجعل النجاح في الاختبارات هو الهدف ويشغل نفسه بضرورة نجاح جميع الطلاب بغض النظر عما إكتسبوه من مهارات أو إستفادوا من لغة ويكون ذلك عن طريق تمكين طلابه من الحفظ الآلي الذي يمكنهم من اجتياز الاختبارات بغض النظر عن دوره في تعليم المادة كلغة وليس كمادة كباقي المواد التي يدرسها الطالب .
*-المعلم الذي يتبع طريقة واحدة في جميع الدروس ومع جميع الطلاب من دون أن يراعي أن هناك تفاوتاً في قدرات الطلاب الفردية.
*-المعلم الذي لا يؤمن بقدسية التدريس ولا يراعي الله في عمله فيهمل طلابه ولا يحاسبهم ولا يهتم بمستوياتهم التحصيلية ولا يحاول إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه طلابه ، كما لا يركز على النقاط الهامة التي يحتاج إليها طلابه .
*- إذا كان معلم المادة سلبياً لا يستجيب للتوجيهات الموجهة إليه من قبل المشرف التربوي أو مدير المدرسة ،ويكون متكاسلاً في تأدية ما يطلب منه من أنشطة تساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية والمساعدة في تنمية لغة طلابه .
*-إذا أهمل المعلم في إعداد الدروس كتابياً وهذا ينعكس سلباً على الأداء الذهني له مما ينتج عنه دروس مملة له ولطلابه تفتقد للتخطيط والتنظيم فيها الكثير من الثرثرة واللف والدوران حول الموضوع بدون فائدة ناهيك عن الارتباك والحيرة ، مما يجعل الطلاب ينشغلون عنه باللعب وكثرة الحركة وتعم الفوضى وتظهر مشاكل وصعوبات يصعب عليه علاجها فيما بعد .
*-إن المعلم الذي يستعمل اللغة العربية بكثرة يساهم بصورة كبيرة في تدني مستوى طلابه ولكن نتيجة لسوء فهم الطلاب لمصلحتهم فنجد أن الطالب يميل أكثر إلى المعلم الذي يقوم بشرح مادة اللغة الإنجليزية باللغة العربية كما أن كثير من معلمي اللغة الإنجليزية لا يستعملون ما بحوزتهم من وسائل تعليمية والتي تساهم مساهمة فعالة لتبسيط أو تسهيل تدريس هذه اللغة .
* بعض المعلمين يركزون على الطلبة الممتازين فقط ولا يعيرون باقي الطلبة أي اهتمام مما يولد لدى هؤلاء الطلاب الكراهية لهذه اللغة وكراهية زملائهم المتفوقين.
*-يميل بعض المعلمين إلى وضع إختبارات ذات أسئلة سهلة جداً ليس فيها مراعاة للفروق الفردية بل أن هذه الأسئلة موجهة للطالب الضعيف وحينما يحصل الطالب على درجات ممتازة يستنتج بطريقة خاطئة أنه لا داعي للاستذكار والدراسة فالمادة سهلة جداً ولا تحتاج إلى أي مجهود .كما أن نظام الاختبارات النصف فصلية وسهولة الأسئلة التي يضعها المعلم لتلاميذه جعلت الطلاب لا يهتمون باللغة الإنجليزية لأنها لا تحتاج لمجهود يذكر للنجاح فيها وبالتالي انعكس ذلك سلباً على أداء التلميذ في نهاية الفصل حيث يأتي الإمتحان على مستوى يتناسب وجميع المستويات هنا يشعر الطلاب بشيء من الصعوبة .
*-عدم قدرة بعض المعلمين في ضبط وإدارة الصف classroom managementوخاصة غير الجنسيات السعودية : فالطالب لا يحترم المعلم إذا لم يكن ذا جنسية عربية ، إذا أن كثير من هؤلاء لا يبالون بالطالب فينصرف الطالب للقيام بأعمال الشعب وإثارة المشكلات في الصف وبالتالي يصرف بقية زملائه عن التركيز في الحصة
دراسة تؤكد ضعف مستوى التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي في الشرقية
--------------------------------------------------------------------------------
شملت 51 ألف طالب وأشارت إلى أكثر من سبب
طالبت دراسة علمية قام بها كل من رئيس التوجيه والإرشاد في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية مبارك بن عبد الهادي الدوسري ومشرف التوجيه والإرشاد في الإدارة عبد الرحمن بن عبد الله العتيبي، بإعادة النظر في الأساليب المتبعة من قبل المعلمين في تدريس مواد اللغة الإنجليزية, والرياضيات, والنحو والصرف وغيرها من المواد التي لوحظ أن ( الخبر, والجبيل, والقطيف، وصفوى, والخفجي وأبقيق) طالبت بضرورة تقييم المنهج المدرسي والمقرر لتلمس بعض الأسباب التي تؤدي إلى ضعف تحصيل الطلاب وتدني مستوى الطلاب في تحصيلها.
وطالبت الدراسة الإحصائية التي أعداها حول التفوق والضعف الدراسي لحوالي 51.400 طالب ( في أكثر من 40 % من مدارس المنطقة الشرقية من المراحل الدراسية الثلاث في الدمام.
وأثبتت الدراسة وجود ضعف واضح في تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي خاصة في مادة الرياضيات الذي تصل نسبته إلى 50 % على مستوى طلاب المنطقة, فيما تبلغ نسبة الضعف في مادة اللغة الإنجليزية 46 % , ومادة الفيزياء 43 %, والنحو 33 %, والكيمياء والأدب والنصوص 32 %, والأحياء 31 %, والحاسب الآلي 28 %.
وأشارت الدراسة كذلك إلى عدم وجود ضعف واضح بين طلاب الصف الثاني الثانوي باستثناء مادة اللغة الإنجليزية التي تصل نسبة الضعف فيها إلى أكثر من 45 %, بينما لا تعيق الطلاب المواد الأخرى مثل الرياضيات والعلوم إذا قورنت بالصف الأول الثانوي.
كما بينت الدراسة أن ضعف الطلاب يتغير نسبياً في تحصيلهم الدراسي في الصف الثالث الثانوي, مما يجعله يتغير تغيراً ملموساً, إذ تبرز لدى الطالب القدرات والرغبة في التحصيل مما يثير استغراب بعض المعلمين وهم يلاحظون هذه التغييرات الفجائية من قبل بعض الطلاب حين يحققون مستوى عال من التفوق على عكس ما عرف عنهم من مستوى ضعيف في السابق.
وقال معد الدراسة مبارك الدوسري لـ "الوطن": إن الهدف من هذه الدراسة التحليلية التي أجريت على جميع مناهج التعليم العام من الصف الرابع الدراسي وحتى الصف الثالث الثانوي بأقسامه, هو الوقوف على مؤشرات علمية ونتائج واقعية من الميدان لإبراز مواد الضعف وأسبابه وتفوق الطلاب في عدد من المواد, وفي مرحلة دون الأخرى, حيث تساعد تلك المعطيات البحث عن الأسباب واقتراح الحلول المناسبة.
وبينما أوضحت الدراسة عدم وجود ضعف واضح في المواد الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية, أظهرت، أيضاً، أن هناك زيادة ملحوظة في ضعف طلاب المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات بنسبة 38%, مقابل حوالي 7% من الطلاب من المتفوقين. وأرجعت الدراسة أسباب هذا التباين بين الضعف والتفوق إلى كثرة المواد الدراسية وازدحامها على طالب المرحلة المتوسطة, والتغير الفسيولوجي للطالب وانتقاله إلى مرحلة نمو جديدة, وقلة استيعاب الطلاب للمادة ورسم صورة خاطئة في أذهانهم عن صعوبة المادة ومساعدة بعض المعلمين لهم على إيجاد هذا التصور الخاطئ , وعدم قدرة ولي الأمر على المتابعة لابنه لصعوبة المادة وعدم فهمها من قبل المنزل, و عدم قدرة الطالب على مسايرة المعلمين في أداء الواجبات والانتباه للدرس مما يجعله فاقداً للمتابعة والاستيعاب.
مستوى اللغه الانجليزيه لدى الطالب الجامعي
توضيح:
ليس الهدف من الموضوع التشهير أو السخريه وانما عرض المشكله وايجاد الحل المناسب لها.
كل ما يرد في هذا الموضوع يعبر فقط عن رأي ولكم حرية قبوله أو رفضه ونحن نقبل الرأي والرأي الاخر.
يعاني معظم الطلاب في الجامعه من تدني مستوى اللغه الانجليزيه وترجع هذه الاسباب الى الخلفيه التي كان يتعلم بها الطلاب اللغه الانجليزيه في المدارس.
ربما هذا لا ينطبق على الطلاب الذين قدموا من مدارس خاصه أو أجنبيه.
ان تدني المستوى واسبابه يؤثر على التحصيل الدراسي لدى الطالب فربما امكاناته العقليه كبيره ولكنه يصطدم بحاجز اللغه والتي ربما تؤدي الى طرده من الجامعه أو البحث عن كليه أخرى مثل الاداب او التربيه حتى يتسنى له التعلم باللغه العربيه.
هنا اضع بعض النقاط والتي من وجهة نظري على اقل تقدير قد تكون حلولا لهذه المشكله.
أولا مشكله النطق:
يعاني الطلاب من نطق الكلامات وهذا ليس بالعيب ولكن ترجع اسبابه الى طبيعة اللسان العربي.
الحل:
أسهل طريقه هي ان تقرأ الكلمه وتردده مرات عديده بينك وبين نفسك وبصوت تسطيع أن تسمعه.
ثانيا القراءه:
هذه المشكله مرتبطه ارتباطا وثيقا بالمشكله الاولى الا وهي النطق حيث أن الطالب لا يستطيع نطق الكلمه مما يؤدي الي صعوبه قراءه جمله كامله.
الحل:
بعد التخلص من صعوبة النطق يجب على المتعلم ان يحاول ترديد الجما ويقرا بصوت أقله ان يسمعه بنفسه ويردد الجمل التي يجد فيها صعوبه ... وتراه التكرار يعلم الشطار ...
ثالثا الكتابه:
هذه المشكله ترجع الى سببين رئيسيين من وجهة نظري ألا وهو عدم المام الطالب بالمفردات أما السبب الثاني صعوبة التفرقه بين الاسم والفعل والصفه لدى معظم الطلاب.
الحل:
أما الحل لهذه المشكله فيحتاج الى كثير من الجهد وعلى الطالب ان يبدا بالجمل البسيطه او المضارع البسيط وان يحدد اولا الافعال في كل جمله وان يحاول لن يتعرف على الفعل.
التركيز على الافعال هي مدخل أساسي لتعلم اللغه الانجليزيه حيث أن كل جمله لا تستقيم بدون فعل.
لذا فان معرفة الفعل في الجمله هي أمر ضروري.
عند تحديد الفعل في الجمله على الطالب ان يحاول ان يخمن معن الفعل من سياق الجمله ومن ثم يبحث عن المعنى.
ربما تكون الطريقه صعبه لكن بعد ذلك ستجد نفسك ملم بعدد لا بأس به من مفردات الافعال.
أما بالنسبه للمفردات فأفضل حل هو القراءه وتحديد أي كلمه جديده ومن ثم كتابة المعنى بالعربي أعلى الكلمه واذا وجدت الكلمه في مكان ثاني ولم تعرف معناها فيجب ان ترجع الى القاموس حتى تحس انك تبذل جهدا ... والي يجي بسهوله يروح بسهوله..
رابعا المحادثه:
أصعب ما قد يكون لدى الطالب هو المحادثه حيث ان معظم الطلاب يحاولون ان يتهربوا من موضوع البرزنتيشن.
الحل:
لحل هذه المشكله لابد على الطالب من وجهة نظري أن يحل المشاكل السابقه حتى يتسنى له جمع قدر اكبر من المفردات وطريقة تركيبها.
بعد الالمام يجب على الطالب أن يكثر من الحديث ويتدرب حتى مع زملائه
أفضل حل هو أن يجلس الطلاب في مجموعات ويناقشوا موضوع معين يختاروه بانفسهم ويطرح كل واحد فكره ويعرض فكرته على زملائه.
يتبع...............
 هايدي
هايدي





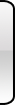

 ارجوا من الجميع المساعدة ...عاجل
ارجوا من الجميع المساعدة ...عاجل



 bermareme
bermareme 


 اتـــــــــــــــــ ي العطـــــــــــــ
اتـــــــــــــــــ ي العطـــــــــــــ  ره .
ره .

