الزملاء الاعزاء تحية طيبة :
================
أتمنى أن تستفيدوا من هذه الملخصات :
فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكير الابتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى طالبات الصف الأول المتوسط بمدينة الرياض
1423هـ / 2002م
أ.وضحى بنت حباب بن عبد الله العتيبي
رسالة ماجستير
قسم التربية وعلم النفس
كليات البنات - كلية التربية
الرياض
ملخص البحث :
استهدف البحث الحالي الإجابة عن السؤالين التاليين
:1 - ما فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تدريس وحدة التغيّر من سنن الله في الطبيعة في تنمية قدرات التفكير الابتكاري لدى طالبات الصف الأول المتوسط ؟
2 - ما فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تدريس وحدة التغيّر من سنن الله في الطبيعة في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الأول المتوسط؟وللتحقق من أهداف هذا البحث وضعت الفروض التالية :
أولاً - الفروض التجريبية :
1 - تؤدي استراتيجية العصف الذهني في تدريس وحدى التغيّر من سنن الله في الطبيعة إلى تنمية قدرات التفكير الابتكاري لدى طالبات الصف الأول المتوسط بصورة أفضل من الطريقة المعتادة.
2 - تؤدي استراتيجية العصف الذهني في تدريس وحدة التغيّر من سنن الله في الطبيعة إلى تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الأول المتوسط بصورة أفضل من الطريقة المعتادة.ثانيًا - الفروض الإحصائية :الفرض الأول :لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي, ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:
1 - 1 لا توجد ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة الطلاقة.
1 - 2 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة المرونة.1 - 3 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة الأصالة.
1 - 4 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة التفاصيل.1 - 5 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بالقدرة الكلية للتفكير الابتكاري.
الفرض الثاني :لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي, ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية :
2 - 1 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي فيما يتعلق بمستويات التحصيل الدنيا.2 - 2 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي فيما يتعلق بمستويات التحصيل العليا.2 - 3 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي فيما يتعلق بالتحصيل الكلي.
واستخدم في هذا البحث التصميم شبه التجريبي المعروف بتصميم القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة غير المتكافئة Pre-Posttest Nonequivalent Control Group Design، وتكونت عينة البحث من (4) فصول من فصول طالبات الصف الأول المتوسط بالمتوسطة الثالثة بعد المائة بمدينة الرياض, وزعت بطريقة عشوائية إلى مجموعتين, حيث مثل فصلان (54) طالبة المجموعة التجريبية درست وحدة التغيّر من سنن الله في الطبيعة باستخدام استراتيجية العصف الذهني, ومثل الآخران (50) طالبة المجموعة الضابطة درست الوحدة ذاتها باستخدام الطريقة المعتادة في التدريس, وقد استخدم اختبار تورانس للتفكير الابتكاري - الأشكال - الصورة (ب) تقنين عبد الله آل شارع وآخرون لقياس قدرات التفكير الابتكاري لدى الطالبات, كما استخدم اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة لقياس التحصيل الدراسي للطالبات, وطبق الاختبارين كليهما قبليًا وبعديًا.
وبمعالجة البيانات الناتجة عن القياس القبلي باستخدام الأساليب الإحصائية التالية :1 - المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري (القبلي - البعدي) في كل قدرة (الطلاقة, والمرونة, والأصالة, والتفاصيل, والقدرة الكلية للتفكير الابتكاري), واختبار التحصيل الدراسي (القبلي - البعدي).2 - أسلوب تحليل التباين المتلازم ذي الاتجاه الواحد One Way Analysis of Covariance، حيث استخدمت درجات الاختبار القبلي كمتغير متلازم لدرجات الاختبار البعدي وذلك للحصول على المتوسطات المعدلة لدرجات الأداء البعدي.3 - مربع إيتا (µ)2 لقياس فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكير الابتكاري والتحصيل الدراسي.
وقد تم التوصل إلى النتائج التالية :
1 - يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة 0.01) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة الطلاقة, وذلك لصالح المجموعة التجريبية, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكير الابتكاري فيما يتعلق بقدرة الطلاقة (7.1%) وهي نسبة متوسطة التأثير.2 - يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة 0.01) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة المرونة, وذلك لصالح المجموعة التجريبية, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكير الابتكاري فيما يتعلق بقدرة المرونة (6.1%) وهي نسبة متوسطة التأثير.
3 - يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة 0.01) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكري البعدي فيما يتعلق بقدرة الأصالة, وذلك لصالح المجموعة التجريبية, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكير الابتكاري فيما يتعلق بقدرة الأصالة (5.2%) وهي نسبة تاثير تقترب من المستوى المتوسط.
4 - لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة التفاصيل, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكير الابتكاري فيما يتعلق بقدرة التفاصيل (2.1%) وهي نسبة ضئيلة التأثير.
5 - يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير الابتكاري البعدي فيما يتعلق بالقدرة الكلية للتفكر الابتكاري, وذلك لصالح المجموعة التجريبية, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكير الابتكاري فيما يتعلق بالقدرة الكلية للتفكير الابتكاري (6.6%) وهي نسبة متوسطة التأثير.
6 - لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي فيما يتعلق بمستويات التحصيل الدنيا, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية التحصيل الدراسي فيما يتعلق بمستويات التحصيل الدنيا (0.36%) وهي نسبة ضئيلة التأثير.
7 - يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي فيما يتعلق بمستويات التحصيل العليا, وذلك لصالح المجموعة التجريبية, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية التحصيل الدراسي فيما يتعلق بسمستويات التحصيل العليا (7.7%) وهي نسبة متوسطة التأثير.
8 - لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (عند مستوى الدلالة < 0.05) بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي الكلي, وقد بلغ حجم فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية التحصيل الدراسي فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي الكلي (2.5%) وهي نسبة ضئيلة التأثير.
وبالتالي أسفرت نتائج البحث عن رفض كل من الفروض الإحصائية (1, 2, 3, 5) المتفرعة من الفرض الإحصائي الأول, وقبول الفرض الإحصائي (4) المتفرع من الفرض الأول, كما أسفرت نتائج البحث عن رفض الفرض الإحصائي (2) المتفرع من الفرض الإحصائي الثاني وقبول الفرضين الإحصائيين (1, 3).
وفي ضوء تلك النتائج قدمت الباحثة عددًا من التوصيات والمقترحات.
فاعلية برنامج سلوكي معرفي في خفض ضغوط العمل لدى معلمات المرحلة الثانوية
1423هـ/2002م
د.لطيفة إبراهيم الشعلان
رسالة دكتوراة
قسم التربية وعلم النفس
كليات البنات - كلية التربية
الرياض
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى فعالية برنامج علاجي سلوكي معرفي في خفض ضغوط العمل لدى معلمات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية , وتكونت عينة الدراسة الاستطلاعية من (106) معلمة تم اختيارهن بطريقة عشوائية من معلمات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية في مدينة الرياض , طبق عليهن مقياس ضغوط المعلمة للتأكد من ثباته وصدقه , أما عينة الدراسة النهائية فقد تكونت من (40) معلمة سعودية من معلمات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية في مدينة الرياض , وقسمت هذه العينة إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية و أخرى ضابطة كل منها تتألف من 20 معلمة .وكانت معلمات المجموعة التجريبية يعملن بمدرسة واحدة , في حين كانت معلمات المجموعة الضابطة يعملن بمدرستين . وقد تم تطبيق مقياس ضغوط المعلمة -الذي أعدته الباحثة - على المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج العلاجي السلوكي المعرفي على المجموعة التجريبية وبعد ذلك تم إخضاع المجموعة التجريبية للبرنامج العلاجي السلوكي المعرفي الذي تكون من(18) جلسة استغرق تنفيذه أسابيع بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا . وعند الانتهاء من البرنامج العلاجي تم إجراء قياس بعدي لضغوط كل من المجموعتين التجريبية والضابطة . وقد استخدمت هذه الدراسة عدة أساليب إحصائية بعضها تم استخدامه في التحقق من ثبات و صدق مقياس ضغوط المعلمة (مثل : التحليل العاملي , والتحليل العاملي التو كيدي , ومعامل ألفا لكرونباخ , والتجزئة النصفية لسبيرمان / براون) والبعض الآخر من الأساليب الإحصائية تم استخدامه في التحليل الإحصائي لنتائج الدراسة النهائية (اختبار"ت" للعينات المستقلة والمرتبطة ,ومربع إيتا). وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج وهي : وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات القياسيين القبلي والبعدي لدى معلمات المجموعة التجريبية في انخفاض جميع مصادر ضغوط المعلمة (الأعباء , العلاقة مع الزميلات , العلاقة مع المديرة , غموض وصراع الدور, التجهيزات والمناهج المدرسية , العلاقة مع الأمهات , خصائص العلاقة مع المشرفة , التقدير المهني ) وذلك لصالح القياس والبعدي . وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي لدى معلمات المجموعة التجريبية في انخفاض أعراض ضغوط المعلمة (الأعراض الفسيولوجية , الأعراض السلوكية , الأعراض الانفعالية )ى وانخفاض الدرجة الكلية لأعراض ضغوط المعلمة وذلك لصالح القياس والبعدي . وذلك باستثناء الأعراض العقلية لضغوط المعلمة , حيث أشارت النتائج إلى أنه رغم وجود انخفاض في درجات الأعراض العقلية في القياس البعدي لدى معلمات المجموعة التجريبية إلا أن الفرق بين متوسطي درجات القياسيين القبلي والبعدي لدى معلمات المجموعة التجريبية في الأعراض العقلية لضغوط المعلمة غير دال إحصائيا . وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات المجموعتين التجريبية و الضابطة في انخفاض جميع مصادر ضغوط المعلمة (الأعباء , العلاقة مع الزميلات , العلاقة مع المديرة , غموض وصراع الدور , التجهيزات والمناهج المدرسية العلاقة مع الأمهات , خصائص وسلوك الطالبات ,العلاقة مع المشرفة , التقدير المهني ) وانخفاض الدرجة الكلية لمصادر ضغوط المعلمة في القياس البعدي , وذلك لصالح المجموعة التجريبية . وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات المجموعتين التجريبية والضابطة قي انخفاض أعراض الضغوط للمعلمة(الأعراض الفسيولوجية ,الأعراض السلوكية الأعراض الانفعالية ) وانخفاض الدرجة الكلية لأعراض ضغوط المعلمة وذلك لصالح المجموعة التجريبية . وذلك باستثناء الأعراض العقلية لضغوط المعلمة إذ أشارت النتائج إلى أنه بالرغم من وجود انخفاض في درجات الأعراض العقلية في القياس البعدي لدى معلمات المجموعة التجريبية إلا أن الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في الأعراض العقلية في القياس البعدي غير دال إحصائيا .
عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات القياسيين القبلي والبعدي في جميع مصادر الضغط والدرجة الكلية لمصادر الضغط لدى معلمات المجموعة الضابطة . عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات القياسيين القبلي والبعدي في جميع أعراض الضغط والدرجة الكلية لأعراض الضغط لدى معلمات المجموعة الضابطة .
وقد تمت مناقشة وتفسير النتائج السابقة في ضوء نتائج الدراسات السابقة المرشدة في هذا المجال , وفي ضوء البرنامج العلاجي السلوكي المعرفي المستخدم,واختتمت الباحثة هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة التي قد تكون توجهات لدراسات مستقبلية
الذكاء الاجتماعي والقيم الاجتماعية وعلاقتهما بالتوافق النفسي والاجتماعي لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز
الأستاذ الدكتور / صالح حسن الداهري
الدكتور / نبيل صالح سفيان
أهمية البحث والحاجة إليه :
فروض البحث :
1- وسط الذكاء الاجتماعي لعينة البحث أعلى بدلالة احصائية من الوسط الفرضي .
2- وسط القيم الاجتماعية أعلى بدلالة احصائية من وسط القيم الاخرى لدى عينة البحث .
3- وسط التوافق النفسي والاجتماعي لعينة البحث أعلى بدلالة احصائية من الوسط الفرضي .
4- توجد علاقة دالة إحصائياً بين الذكاء الاجتماعي وكلٍ من التوافق الاجتماعي والتوافق النفسي .
5- توجد علاقة دالة إحصائياً بين القيم الاجتماعية وكلٍ من التوافق الاجتماعي والتوافق النفسي.
6- توجد فروق دالة إحصائياً في الذكاء الاجتماعي لدى عينة البحث وفقاً لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية .
7- توجد فروق دالة إحصائية في التوافق النفسي لدى عينة البحث وفقاً لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية .
8- توجد فروق دالة إحصائية في التوافق الاجتماعي لدى عينة البحث وفقاً لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية .
9- توجد فروق دالة إحصائياً في القيم الاجتماعية لدى عينة البحث وفقاً لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية .
10- توجد فروق داالة إحصائياً في التوافق النفسي وفقاً لمتغيري الذكاء الإجتماعي والقيم الاجتماعية معاً .
11- توجد فروق داالة إحصائياً في التوافق الاجتماعي وفقاً لمتغيري الذكاء الإجتماعي والقيم الاجتماعية معاً .
حدود البحث :[/color
يـقـتصر هــذا البـحث على طلـبة علـم النـفس اليمنـين في جامعة تعز للعام الدراسي 1996/1997 كما يقتصر في دراسته للقيم على القيم الاجتماعية فقط حسب تصنيف سبرانجر واختبار البورت فيرنون ولندزي للقيم .
مصطلحات البحث:
الذكاء الاجتماعي :
تعددت تعاريف الذكاء العام بحسب تعدد المشارب التي نهل منها معرفوه ، وأختلفت باختلاف الفلسفات والنظريات النفسية والمنهجيات المتبعة في دراسته فالمنظرون الذين أستخدموا التحليل العاملي في بحوثهم وركزوا على دراسة الفروق الفردية أمثال جيلفورد وسبيرمان وثرستون وغيرهم لاشك أنهم يختلفون نوعاً ما عن التطوريين والمؤمنين بالمنهج الوصفي أكثر من الكمي أمثال بياجيه وكولبرج وداموند ....الخ .
وفي الذكاء الاجتماعي كان الاختلاف أكثر عمقاً لأن مفهوم الذكاء الاجتماعي أقل إثباتاً وتناوله أكثر من تخصص ،
وبعد أن اطلع الباحث على عدد من التعاريف عرف الذكاء الاجتماعي بانه : فهم الناس بكل ما يعنيه هذا الفهم من تفرعات أي فهم افكارهم واتجاهاتهم ومشاعرهم وطبعهم ودوافعهم والتصرف السليم في المواقف الاجتماعية بناء على هذا الفهم ، ويعرفه اجرائياً بأنه ما يقيسه مقياس الذكاء الإجتماعي في هذا البحث .
القيـــــــم :
تعدد التعريفات واختلفت في بعض الامور نتيجة لاختلاف تخصصات ومذاهب واتجاهات اصحابها فبعضهم يعرفها من خلال مؤشر الاتجاه كالبورت وبعضهم يعرفها من خلال مؤشر الانشطة السلوكية وبعضهم يعرفها من خلال مؤشري الاتجاه والنشاط السلوكي معا وبعضهم من خلال التصريح المباشر كروكش .
ويعتمد الباحث في هذه الدراسة تعريف القيم الاجتماعية لإلبورت وهو الاتجاه الذي يرتبط باهتمام الفرد بافراد المجتمع , حيث عرفت بأنها ( تعكس اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس فهو يحبهم ويميل إلى سعادتهم وينظر إليهم كغايات وليسوا وسائل لغايات أخرى ، ويتميز حاملوا هذه القيمة بالعطف والحنان والإثارة ( هناء ، 1959 :603 )، ويعرفه الباحث اجرائياً هومايقيسه اختبار القيم المطبق في هذا البحث .
التوافق :
وكما هو الحال في مصطلحي الذكاء الاجتماعي والقيم هو ايضاً في التوافق النفسي والاجتماعي ، ويعرفه الباحث هنا بأنه : اشباع الفرد لحاجاته النفسية وتقبله لذاته واستمتاعه بحياة خالية من التوترات والصراعات والامراض النفسية ، واستمتاعه بعلاقات اجتماعية حميمة و مشاركته في الأنشطة الاجتماعية ، وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه .
اجراءات البحث :
مجتمع البحث :
يتكون مجتمع البحث من طلبة علم النفس في جامعة تعز لعام 1997 من المراحل الدراسية الثانية والثالثة والرابعة ذكوراً وأناث والبالغ عددهم (828) طالباً وطالبةً ، استبعدت المرحلة الدراسية الأولى باعتبارها فئة خاصة حيث جميع طلبتها من المتبقين من العام السابق *
عينة البحث :
وتّم اختيار عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها النهائي ( 327 ) طالباً وطالبةً بنسبة مئوية 39.49% ،وهي نسبة تتناسب مع أ
أدوات البحث :
لغرض تحقيق اهداف البحث عمد الباحث الى اعداد أداتين الأولى تقيس الذكاء الاجتماعي والثانية تقيس التوافق النفسي و الاجتماعي ولتوفر أداة مناسبة تقيس القيم الاجتماعية وهي اختبار القيم لإلبورت فيرنون ليندزي والذي كيفه الباحث على البيئة اليمنية سابقاً ( سفيان ، 1995 : 100-109) فقد تمّ استخدامها وفيما يلي توضيح لكل أداةٍ وكيفية اعدادها.
تفسير النتائج ومناقشتها :
وبعد عرض ما توصل إليه البحث من نتائج يحاول الباحث مناقشة هذه النتائج وفق كل فرض ونتيجة كما يلي :
1- يتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بذكاء اجتماعي عالٍ ، وهذه النتيجة تتفق مع الأدب النظري لكون المرشد والإخصائي النفسي يجب أن يتحلى بذكاء اجتماعي عالٍ وقد أكدت دراسة هامرن ويولس على أهمية صفة الذكاء الاجتماعي للمرشد النفسي Sherzer&Stone, 1987 : 122) ) كما أكد على ذلك مرعي (1983) ، وأتفقت هذه النتيجة مع معظم الدراسات ومنها : دراسة (1984)Wood و (1967)John و محسن (1983) ، إلاّ أنها لم تتفق مع دراسة الديب (1987) .
2- يتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بقيم اجتماعية عالية ، وهذه النتيجة أكد عليها الأدب النظري حيث أكد هنا (1959) على ارتباط نجاح المرشد بمهنته بالقيم الاجتماعية (هنا ، 1959 : 713 ) ، كما عرضت رو (Roe) دراسة تعبر عن العلاقة بين القيم الاجتماعية ومهنة الاخصائي الاجتماعي (هنا ، 1959 : 186-188) ، كما أوردت العديد من الدراسات خصائص الاهتمام بالاخرين ، وحب الناس ، والرغبة في المساعدة ، وحب الآخرين كا الجمعية الأمريكية لتوجيه الأفراد المهنية (1949) (Sherzer&Stone , 1987 : 122 ) وأبوعيطه (1988) (أبوعيطه ، 1988 : 75-77) و السالم (1986) (السالم ، 1986 :37 ) و مرعي (1983) ( مرعي ، 1983 :179-180) ، كما أتفقت هذه النتيجة مع دراسة سفيان (1995) (سفيان ، 1995 : 72 ) .
3- يتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بتوافق نفسي واجتماعي عاليين ، وتتفق هذه النتيجة مع ماأكد ه الأدب النظري من ضرورة تمتع المرشدين والأخصائيين النفسـيين بالتـوافق النفسي والاجتماعي والنضج الشخصي والصحة النفسية والأتزان الأنفعالي (Sherzer&Stone , 1987:122) ) ، (أبوعيطه ، 1988 : 77 ) (السالم 1986 :37 )
( مرعي ، 1983 : 179-180) ، و أتفقت هذه النتيجة مع دراسة السوداني ( 1991) التي توصلت إلى تمتع المرشدين التربويين في العراق بتوافق شخصي واجتماعي عال .
4- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الذكاء الاجتماعي والتوافق الاجتماعي والنفسي ، يرى الباحث أن الذكاء الاجتماعي يرتبط بالتوافق الاجتماعي وكما جاء في هذه النتيجة إلاّ أنه ليس إرتباطاً تاماً كما يعتقد البعض ، فقدرة الفرد على فهم الآخرين والقدرة على التصرف بحكمة في المواقف الاجتماعية هو جانب إدراكي والتوافق في رأي الباحث نتاج عوامل عقلية وجدانية اجتماعية ، فهناك عوامل إنفعالية تجعل الفرد يسلك سلوكاً أحمقاً من الجانب الاجتماعي مع إدراك الفرد لذلك ولكنه مضطر ليشبع دافع ما أو رغبة ، ويؤكد فالي ) Foly, 1971 ) أنّ الفهم الحقيقي للأخرين ضروري للتصرف الحكيم في المواقف الاجتماعة ولكن ليس دائماً ، كما أتفقت هذه الدراسة مع عدد من الدراسات بشكلٍ جزئي فقد توصلت معظم الدراسات إلى وجود علاقة بين الذكاء الاجتماعي او بعض مجالاته وبعض المفاهييم القريبة منه - كالأدراك الاجتماعي والمهارة الاجتماعية - مع التوافق او بعض مجالاته كدراسة (1977)Wechman و دراسة (1987) Monson و Hunt (1928) ، وأمّا التوافق النفسي فقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الذكاء الاجتماعي والتوافق النفسي ، ورغم دلالة العلاقة إحصائياً إلاّ أنها تبدو في نظر الباحث غير قوية ومع ذلك فإنّ هذه النتيجة أتفقت مع ما أوصى به الأدب النظري ونتائج معظم الدراسات السابقة فقد أوصى أبوحطب (1991) بدراسة العلاقة بين ما يسميه الذكاء الشخصي ( فهم الذات ) والصحة النفسية ، كما أوصى (1984) Marlowe بدراسة الفعالية الاجتماعية ودورها المخفف للضغوط والتوترات والاتصال الشخصي.
و أكدت الدراسات بشكلٍ وبآخر علاقة الذكاء الاجتماعي بالتوافق النفسي وإن ركزت معظمها على المرضى النفسيين أي ذوي سوء التوافق الشديد ، ومن هذه الدراسات دراسة (1986)Wilbrt و (1986)Alexander و (1980) Monson و ابوسريع (1987) و (1981) Schoeri و (1988) Longford و (1985) Rubin .
5- توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيم الاجتماعية والتوافق النفسي والاجتماعي، وهذه النتيجة لا تتفق مع جانب من الأدب النظري فقد أكد الداهري والعبيدي أنّ الشخص المتوافق يتمثل فيه نسق للقيم منها القيم الإنسانية ( الداهري واالعبيدي ، 1994) ، أمّا الدراسات السابقة فقد ركزت على قيم أخرى غير القيم الاجتماعية كالقيم الدينية ، والدراسات التي تناولت القيم الاجتماعية فقد تناولتها من منظور مختلف عن المنظور الحالي ومن هذه الدراسات دراسة راؤوف (1992) التي توصلت الى ان القيم الاجتماعية والاخلاقية لها دور مؤثر في خصائص الشخصية من حيث السواء وغير السواء ، ويتضح مما سبق أن علاقة القيم الاجتماعية من منظور البحث الحالي لم تدرس حسب علم الباحث وانها لم ترق إلى مستوى الدلالة هنا راجع في رأي الباحث إلى أن القيم وحدها لاتكفي لإحداث التوافق بل هناك عوامل أخرى، وأستنتجت دراسة مقدم (1994) أن القيم ما هي إلا عامل من عوامل الشخصية.
6- توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الذكاء الاجتماعي تبعاً لمتغير الجنس ، ولكن وجد ت فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية لصالح طلبة المرحلة الرابعة ، فبالنسبة للجنس ، اختلفت هذه النتيجة مع الدراسات الغربية حيث اكدت معظم الدراسات الغربية ان الاناث اعلى درجة في ذكائهن الاجتماعي من الذكور كدراسة هنت Hunt(1928) ودراسة فالي (1971)Foly كما وجدت دراسة (1979)Gcmmings فروقاً في الجنس إلاّ أنّ الدراسة كانت قد طبقت على الاطفال ، وفسرت هنت بأنّ سبب ذلك يرجع لكون الاناث أكثر حاجةً من الذكور للانسجام مع الاخرين ( Hunt ,1928 ) ، إلاّ أنّ نتيجة البحث هذه أتفقت مع الدراسات العربية فقد توصلت إلى عدم وجود فروق معنوية كدراسة الدماطي (1991) ودراسة محسن (1983) ، ووجدت بعض الدراسات العربية ان الفرق لصالح الذكور في التصرف في المواقف الاجتماعية وقدرة ادراك الظروف الاجتماعية كدراسة الديب (1987) (الدماطي ، 1991 : 83 ) . ويفسر الباحث عدم وجود الفروق بل واحيانا لصالح الذكور بانه قد يعود الى ظروف الثقافة العربية والعادات التي تقيد حركة المرأة في الاوساط الاجتماعية التي تقلل من تنمية ذكائهن الاجتماعي على عكس المجتمعات الغربية برغم حاجتهن الى الانسجام مع الاخرين ، وبالنسبة للمرحلة الدراسية وتـطور الذكـاء الاجتماعي عبر المراحل الدراسيـة فهذه النتيجة تتـفـق مـع الأدب الـنظري فالذـكاء الاجتماعي ينمو عن طريق الخبرة والإحتكاك الاجتماعي ، فـهـنت ( Hunt ,1928) ترى بانه يمكن تنمية مخزون الفرد من المعلومات الاجتماعية اكثر من غيره من عناصر الذكاء الاجتماعي بصورة واعية وبجهد ارادي والدليل الآخر على ان المعلومات الاجتماعية يتم بناؤها من خلال تجارب واتصالات محددة هو ان التغيير في عنصر المعلومات يرتبط بالتغيير في سن الفرد، فالمعلومات الاجتماعية للراشد تختلف تماما عن معلومات الطفل من حيث الكم والنوع ( Hunt ,1928 ) كما اكدت ذلك نتائج دراسة Walker (1973) ودراسة Foley (1971) ، ولتأثير الخبرة التعليمية على تنمية الذكاء الاجتماعي أتفقت هذه الدراسة مع دراسة Kinter (1980) وLecory (1983) وJukson (1983) ، وبهذا فإنّ تفسير تطور الذكا هنا يعود في رأي الباحث إلى نمو خبرة الطالب المنظمة المتمثلة بمقررات تخصصه تتعلق بفهم الطبيعة الانسانية.
7- توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق النفسي تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية ، ولكن وجدت فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس لصالح الذكور ، وتشير هذه النتيجة إلى أنّ برامج الجامعة والمناخ الجامعي لايؤثر سلباً أو إيجاباً في التوافق النفسي ، وبالنسبة لمتغير الجنس فإنّ هذه النتيجة تتفق مع معظم الدراسات ، ومنها دراسة كلٍ من : كاروبندر(1996) و التكريتي (1989) و الشناوي وخضر (1988) ، ولم تتفق مع دراسة الدوري (1993) . ولعل هذا الفرق يرجع إلى ظروف الأنثى وتكوينها النفسي والبيلوجي والاجتماعي ، والأنثى أكثر حساسية في مواجهة المشكلات والصدمات وأقل قدرة على تحمل الضغوط ، وعواطف وأنفعالات الأنثى تحتل الجانب الأهم في توجيه سلوكها .
8- توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق الاجتماعي تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية ، ولكن وجدت فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس لصالح الذكور ، وهذه النتيجة تعتبر مؤشراً لعدم تأثير برامج ومناخ الجامعة في التوافق الاجتماعي سلباً أو إيجاباً ، و بالنسبة لمتغير الجنس فإنّ هذه النتيجة تتفق مع دراسة كلٍ من عبدالفتاح ( 1992) والشناوي وخضر (1988) ، وتختلف مع دراسة الدوري (1993) ، ولعل هذا يعود ايضاً للظروف النفسية والاجتماعية للأنثى ، وتزداد المشكلة في البلدان العربية والبيئة اليمنية بسبب العادات والتقاليد التي تقيد احتكاك الأنثى وتضيق دائرتها الاجتماعية .
9- توصلت الدراسة إلى وجود تفاعل في متغير القيم الاجتماعية بين الجنس والمرحلة الدراسية ، فبينما تظهر الإناث قيماً اجتماعية أعلى من الذكور في المرحلة الثانية والرابعة يظهر الذكور قيماً اجتماعية أعلى من الإناث في المرحلة الثالثة ، فبالنسبة للجنس يـبدو أنّ الإناث تكاد تتـفوق على الذكور في القيم الاجتماعية وذلك لتفوقها عليهم في مرحلتين مقابل مرحلة دراسية واحدة وهي المرحلة الثالثة وعلى كلٍ فتـفوق الإناث على الذكـور تتفق مع معظم الدراسات منها دراسة كلٍ من زهران وسري (1985) وسفيان (1995) . ويفسر الباحث ذلك بأنه عائد ألى تكوين الأنثى النفسي والبيلوجي في رقة عواطفها ورهافة مشاعرها وعلاقتها بالآخرين هو مركز اهتمامها ، وبالنسبة لمتغير المرحلة الدراسية فقد أشار الأدب النظري إلى أنّ الطلبة يكتسبون قيمهم من خلال محتوى المنهج و من خلال التعبير الصريح للقيم من قبل مدرسيهم داخل القاعات الدراسية وخارجها وعن طريق توحد هؤلاء الطلبة ببعض مدرسيهم وتبني قيمهم وهذا ما أكدته دراسة جيروس (حسين ، 1981 : 70 ) ، و للتخصص علاقة بالقيم فالتخصص يحمل قيماً نوعية تتناسق مع قيم الفرد الذي له علاقة به ، وان لم يكن التخصص هو الذي يؤثر بقيم الفرد فاختيار تخصص ما له علاقة بقيم الفرد ، وبالنسبة لتطورها عبر مراحل الدراسة أيضاً فهذه النتيجة المتمثلة في ضعف تأثير المرحلة الـدراسية تتفـق مع دراسة سفـيان (1995)على نفس الجامعة ودراسة صالح (1984) و العمري (1983) ، وبالنسبة للقيم الاجتماعية فقد ارتبطت بالتخصص النفسي الاجتماعي في دراسة كلٍ من بكر (1975) وكاظم (1962) والبطش وعبد الرحمن (1990) .
و يفسر الباحث هذا التناقض بأنه يعود لاختلاف الجامعات وفاعلياتها في تنمية القيم بصورةٍ عامة والاجتماعية بصورةٍ خاصة ، ولعل سبب آخر وهو ارتفاع مستوى هذه القيم منذ التحاق الطالب في قسم علم النفس توحي بعلاقة ميله إلى تخصص علم النفس بقيمه الاجتماعية ولأنّ البرامج الدراسية في قسم علم النفس ضعيفة لم يظهر أثرها للتفوق المسبق.
10- توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق النفسي تبعاً لمتغير الذكاء الاجتماعي والقيم الاجتماعية معاً ، ورغم أنّ هناك علاقة وجدت بين الذكاء الاجتماعي والتوافق النفسي ورغم دلالتها الاحصائية إلاّ أن درجة الارتباط لم يكن عاليا كالتوافق الاجتماعي وذلك لأنّ علاقة الذكاء الاجتماعي بالتوافق النفسي ليست مباشرة كما هو الحال بالنسبة للتوافق الاجتماعي وكذلك القيم الاجتماعية ، ويتضح من هذه النتيجة أنّ الفروق في التوافق النفسي تبعاً للذكاء الاجتماعي والقيم الاجتماعية ضعيفا وغير دال ولعل من ضمن أسباب ذلك عدم وجود العلاقة المباشرة على عكس التوافق الاجتماعي والسبب الآخر هو أنّ مجتمع البحث مجتمع يخلو من ذوي التوافق النفسي السيء جداً ويتبين ذلك ويبدو أنّ الفروق في الذكاء الاجتماعي تظهر من خلال المقارنة بين ذوي سيئي التوافق النفسي الشديد وهم المرضى النفسيين والجانحيين ولهذ كانت معظم الدراسات التي توصلت إلى فروق في الذكاء الاجتماعي طبقت على المرضى والجانحين والمعاقين ومن هذه الدراسات دراسة كلٍ من : (1988)Wilbrt و (1986)Alexander و (1980) Monson و (1981) Schwoeri و(1988) Longford و (1985) Rubin .
11- توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق الاجتماعي تبعاً لمتغير الذكاء الاجتماعي والقيم الاجتماعية معاً لصالح ذوي الذكاء الاجتماعي العالي والقيم الاجتماعية الوسطى ، تتفق هذه النتيجة مع الإطار النظري والدراسات السابقة وتقترب من الواقع المعاش فبالنسبة للذكاء الاجتماعي العالي ، فقد قرن الذكاء الاجتماعي بالإنسجام مع المجتمع ، فذوي الذكاء الاجتماعي العالي أفضل في توافقهم الاجتماعي من ذوي الذكاء الاجتماعي الواطي ، وهذه النتيجة تتفق مع عدد من الدراسات التي تناولت الذكاء الاجتماعي أوالمفاهييم المشابهة له وعلاقته بمجالٍ أو أكثر من مجالات التوافق الاجتماعي وهي دراسة كلٍ من (1977) Wechman و (1987)Monson ) و Hunt (1928) أمّا بالنسبة لتفوق القيم الاجتماعية المعتدلة ( الوسطى) فهي تبدو منطقية ، فهذه النتيجة تشير إلى أنّ التطرف والشدة في الاهتمام بالآخرين يؤدي إلى سوء التوافق الاجتماعي ، وربما يرتبط هذا بالإندفاع نحو الآخرين ، كما أنّ الاهتمام الشديد بالآخرين والمبالغة في حبهم قد يؤدي إلى نتائج عكسية ، فقد ينفر وقد يثير الشكوك والمخاوف وقد يجعل الشخص المحب يلتصق بمن يحبهم إلتصاقاً يزعجهم ، كما أنّ الحب المبالغ بالآخرين يولد الحساسية من سلوكهم نحوه وقد يعرضه للصدمات معهم نتيجة لعدم مبالاتهم مقابل اهتمامه الزائد عن الحد الطبيعي ، ولعل الشخص كثير الاهتمام بالآخرين ترتبط به خصائص تتعلق بخاصية الإهتمام تؤدي إلى سوء التوافق الاجتماعي ، ومعظم الدراسات تناولت القيم الدينية مقابل التوافق النفسي أمّا التي تناولت القيم الاجتماعية فمن منظور مختلف عن هذا المنظور .
ومن ضمن أستنتاجات هذا البحث :
- أن الذكاء الاجتماعي أكثر أهمية من القيم الاجتماعية بالنسبة للتوافق الاجتماعي .
- التطرف في القيم الاجتماعية والتي تعني الإهتمام الزائد أو غير المعتدل بالأخرين يقلل من التوافق الاجتماعي.
وفي ضوء النتائج ومن ضمن توصيات البحث ومقترحاته مايلي :
- تطبيق مقاييس واختبارات الذكاء الاجتماعي والتوافق النفسي والاجتماعي والقيم على الطلبة الراغبين في الإلتحاق في قسم علم النفس لما لهذه الخصائص من علاقة هامة بمهنة المرشد والأخصائي النفسي .
- وضع مقرر لطلبة قسم علم النفس يتضمن بصورةٍ مباشرة الموضوعات التي تتعلق بعلاقة الفرد بالآخرين .
- عمل برامج ارشادية لدعم التوافق النفسي والاجتماعي خاصة لدى الإناث من طالبات الجامعة عموماً وفي قسم علم النفس خصوصاً .
- بناء مقياس للقيم منطلقاً من الثقافة االعربية الإسلامية وعلى أسس علمية نفسية اجتماعية موضوعية .
ولاً : المصادر العربية
ابوحطب ، فؤاد ( 1991) الذكاء الشخصي ( النموذج وبرنامج البحث ) ، الجمعية النفسية للدراسات النفسية ، المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر ، مكتبة الأنجلوالمصرية ، القاهرة .
ابوسريع ، اسامة سعد (1987) اضطراب المهارات الاجتماعية لدى المرضى النفسيين ، مجلة علم النفس ، العدد (1) يناير ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
ابوعيطة ، سهام درويش (1988) مباديء الارشاد النفسي ، طـ 2، دار العلم للنشر والتوزيع ، الكويت .
البطش ، محمد وليد وعبدالرحمن ، هاني (1990) البناء القيمي لدى طلبة الجامعة الاردنية ، مجلة دراسات ، الجامعة الاردنية ، سلسلة العلوم الانسانية ، المجلد السابع عشر (أ) العدد (3) .
بكر ، محمد الياس (1975) دراسة مقارنة في القيم بين طلبة الجامعة والثانوية ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) ، جامعة بغداد.
التكريتي ، واثق عمر موسى (1989) بناء مقياس للتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة (بناء وتطبيق) ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) ، كلية الاداب ، جامعة بغداد .
حسين ، محي الدين احمد ( 1981 ) القيم الخاصة لدى المبدعين ، دار المعارف ، القاهرة
الداهري ، صالح حسن احمد والعبيدي ، ناظم هاشم (1994) الشخصية والصحة النفسية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بابل ، كلية التربية، الشؤون العلمية .
الدماطي ، فاطمة عبد السميع محمود (1991 ) الذكاء الاجتماعي وعلاقته بكفاءة التدريس لدى طلبة دور المعلمين ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .
دواني ، كمال وديراني ، عيد (1983) اختبار ماسلو للشعور بالامن ، دراسة صدق للبيئة الاردنية ، مجلة دراسات ، المجلد (10) العدد (2) ، الجامعة الاردنية .
الدوري ، سافرة سعدون احمد (1993) الحاجات النفسية لدى طلبة جامعة بغداد وعلاقتها بتوافق النفس الاجتماعي ، اطروحة دكتوراه ( غير منشورة ) ، جامعة بغداد ، كلية التربية (ابن رشد) .
رؤوف ، ابراهيم عبد الخالق ( 1992 ) دراسة القيم وخصائص الشخصية ، خلاصة ابحاث الندوة العلمية الأولى عن السلوك المنحرف والأمن الاجتماعي ، التي اقامها قسم الارشاد التربوي في كلية التربية جامعة البصرة من 13 ، 14 مارس .
زهران ، حامد عبد السلام (1980) التوجيه والإرشاد النفسي ، عالم الكتب ، القاهرة .
السالم ، مها يوسف (1986) دور المرشد والمسترشد في نجاح العملية الارشادية، مجلة التربية، العدد (4) ، السنة (3) ، كلية التربية ، جامعة البصرة .
سفيان ، نبيل صالح (1995) القيم السائدة لدى طلبة جامعة صنعاء (فرع تعز ) رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية التربية ، الجامعة المستنصرية .
السوداني ، يحيى محمود سلطان ( 1990 ) قياس التوافق الاجتماعي والنفسي لأبناء الشهداء في المرحلة المتوسطة ، اطروحة دكتوراه ( غير منشورة ) كلية التربية ، جامعة بغداد .
الشناوي ، محمد محروس محمد وخضر ، على السيد (1988) الاكتئاب وعلاقته بالوحدة وتبادل العلاقات الاجتماعية ، بحوث المؤتمر العلمي الرابع لعلم النفس الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، مصر 25،27 يناير ، القاهرة .
صالح ، قاسم حسين وآخرون (1984) التغيرات في القيم لدى طلبة الجامعة دراسة تطبيقية على طلبة جامعة بغداد ، بحث غير منشور .
عبدالفتاح ، يوسف (1992) ديناميات العلاقة بين الرعاية الوالدية كما يدركها الابناء وتوافقهم وقيمهم ، مجلة علم النفس ، العدد (24) اكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة.
عمر ، ماهرمحمود ( 1988) سيكولوجية العلاقات الاجتماعية، دارالمعرفة الجامعية ، الإسكندرية
القاضي ، يوسف مصطفى وآخرون (1981) الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي ، دار المريخ ، الرياض .
قنصوة ، صلاح (1986 ) نظرية القيمة في الفكر المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة
كاروبندر ، لويس (1996) دراسة مقارنة ، التفكير الابتكار التوافق النفسي الاجتماعي لطلبة مدراس المتميزين واقرانهم في المدارس الاخرى ، اطروحة دكتوراه ، ( غير منشورة ) كلية الآداب جامعة بغداد .
كاظم ، محمد ابراهيم ( 1962) تطورات في قيم الطلبة ، دراسة تربوية تتبعية لقيم الطلاب في خمس سنوات ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة .
محسن ، عبد الرحيم (1993) مهارات الاتصال لدى المرشد التربوي في المدارس المتوسطة من مدينة بغداد ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) ، كلية التربية ، الجامعة المستبصرية ،
مرعي ، ابراهيم بيومي (1983) الاستعداد الشخصي واهميته في اعداد الاخصائي الاجتماعي (دراسة للتجربة المعرفة) ، مجلة كلية الاداب ، المجلد العاشر، الجامعة المستنصرية .
المغربي ،سعد ( 1992) حول مفهوم الصحة النفسية أو التوافق ، مجلة علم النفس العدد(23) ، يوليو أغسطس سبتمبر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
مقدم ، عبدالحفيظ (1994) علاقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع الاتجاهات والسلوك دراسة امبريقية" مجلة العلوم الاجتماعية ، المجلد (22) العدد(1) ، الكويت.
ملكوش ، رياض (1996) تاثير علم نفس الاتصال في الميل الاجتماعي في اطار نظرية ادلر لدى عينة من طلبة الجامعة الاردنية ، مجلة دراسات، المجلد الثالث والعشرون ، العدد (2) ، الجامعة الاردنية .
الهاشمي ،عبد الحميد محمد (1986) التوجيه والإرشاد النفسي ( الصحة النفسية الوقائية ) دار الشروق ، جدة .
هناء ، عطية محمود ( 1959 ) ( دراسات حضارية مقارنة في القيم ) في ، لويس كامل مليكة قراءات في في علم النفس الاجتماعي في البلاد العربية ، الجزء الاول ، ط (2) ، القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر .
هناء، عطية محمود( 1962) التوجيه التربوي والمهني، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
Alexander,Dennis.Jay (1986) An Exploration of Factors Useful in Predicting Avoidance Behavior Among the Spinal Co?rd Injured (Physical Disabled,social Avoidance,Handicapped), Dissertation (A) Abstract (I) International (DAI) 47/06 B, P. 2601 .
Bloom , B.S ,et.al( 1971 ). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student learning .McGraw - Hill , New york .
Downi , N .M.( 1976 ) Fundamentals ,of Measurment .2nd.ed . Exford University Press , New york .
Foley, Walker, Shanl (1971) Scocial Intellegence : A concept in Search of Data, Psychological Report, 1971, 29,11232, Psychological report.
Gifford, Dorothy Kohl (1988),Patterns of Empathy,Anxiety and Performance Self-esteem in Psychologists in Independent Practice,(D.A.I ) 49/11 B, .
GronIund , N .( 1965 ) Measurement and evaluation in Teaching . Macmillan Co , New York .
Gummings,Leonard Otto. 111(1979),Social Intelligence and Classroom Adaptive Behavior,(D.A.I ) 40/08 A..
Hgelle, L. and Ziegler ,D.(1988).Personaliety Theories. Basic Assumptions, Research and Applications. McGrow-Hill Co. London.
Hunt, T.(1928) The Measurement of Social Intelligence. Journal of Applied Psychology, Vol:XII,. pp. 317-334.
Jackson,Sara Cargill(1983),Analysis of Social Perceptual Ability in Learning Disabled and Nonhandicapped Adolescents. (D.A.I) 45/01 A .
John Bottriil (1967) The Social Intelligence of Students the Journal of Psychology ,July vol. 66, Second.
Kinter, and kaylee(1980) Deca Leadership Training and post-High school leadership Roles. (D.A.I) 41/06 A, .
Langford (197) Social Skills Versus Self-Monitoring as Psychoeducational treatment , Approaches for Conduct Disorder - Depessed Adolecents (D.A.I) 49 / 04 A, No. ??.
Lecroy,Craig Winston,(1983). Promoting Social Competence in Early Adolescents : An Experimental Investigation,(D.A.I) 45/02A.
Marlo, Herberta, J(1984),The Structure of Socu?ial Intelligence (Competence Skills,Behavior),(D.A.I) 45/07A.
Munson,janet Louise (1987), Social Perception Skill and Social Adjustment in Underachieving Children Classified According to Pattern of Academic Disability, (DAI) 48/08B.
Osipow, Samul H.and Walsh, W. Bruce .(1973) Social Intelligence and the Selection of Counselors . Journal of counseling psychology:20,4,A,366-369 , Jul.
Raviv,Dan.(1983), The Relationship Between Situational Self-Disclosure,Self-Disclosure,(D.A.I) 44/08 A,.
Rubin ,Avery (1985) Social Intelligence and Social Competence Among Psychiatric Diagnostic Grops, (D.A.I ) A7/02b,.
Schwoeri, Francis John (1981) Attentional Processes in Social Perception: Differences and Similarities Among Learning Disabled, Delinquent, and Normal Adolescents (D.A.I) 44/05b, p.1643.
Sherzer and Stone (1987) Fundamentals of Guldance .
Stanley, Julian C., and Knneth D. Hopkins (1972): Educational and Psychological Measurement and Evaluation, 4th.ed. Prentice Hall International, Inc., London.
Walker, R. E. and Foley, J. M.(1973) Social Intelligence: Its History and Measurment. Psychological reports. Vol:33,.
Weichman,Marilyn Hutchinson (1978) The Relationship of Children's Social Intelligence to Measures of Rntrapersonal and Interpersonal Social Adjustment (D.A.I) B.
Wilbert, Jeffry Robert (1986), Disfunctional Attitudes, Social Skills Deficits, and Loneliness Among College Students:the Process of Social Adjustment (Interpersonal Relations),(D.A.I) 47/01b.
Wood, Gloria Blanche,(1984),The Accuracy of Counselors' First Impressions Using Methods Based on the Interpersonal Tracking Task and the Theory of Signal Detection (Person-Perception, Social Perception),(D.A.I) 45/05b.
"أثر استخدام كل من دورة التعلم ونموذج جانييه على اكتساب عينة من تلميذات الصف الثالث الابتدائي بمدينة الرياض للمفاهيم العلمية ومهارات الملاحظة والتصنيف والاتصال"2003م
د .مي عمر عبد العزيز السبيل
رسالة دكتوراة
قسم التربية وعلم النفس
كليات البنات - كلية التربية
الرياض
وقد بلغت عينة الدراسة ست وتسعون تلميذة، موزعات على ثلاثة فصول للصف الثالث الابتدائي، بواقع اثنين وثلاثين تلميذة في كل فصل. استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، كما استخدم التصميم التجريبي نظام المجموعتين التجريبية والضابطة ذات القياس القبلي والبعدي. وقد أعدت الباحثة مواد وأدوات متعددة منها:
1- مرشد للمعلمة باستخدام دورة التعلم.
2- أوراق عمل للتلميذة باستخدام دورة التعلم.
3- مرشد للمعلمة باستخدام نموذج جانييه.
4- اختبار اكتساب المفاهيم.
5- اختبار عمليات العلم.
وتوصل البحث إلى العديد من النتائج منها: أوضح اختبار تحليل التباين لنتائج الاختبار البعدي المؤجل في اختبار اكتساب المفاهيم العملي، وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعات الثلاث، وهذه النتائج تظهر تأثير دورة التعلم، ونموذج جانييه في نتائج اختبار اكتساب المفاهيم العملي، مما يوضح أن الأطوار المختلفة لدورة التعلم ، وأنشطة التعليم والتعلم المختلفة في نموذج جانييه، تؤثر بصورة ملحوظة على نتائج اختبار اكتساب المفاهيم العملي في المجموعتين التجريبيتين. كما أظهرت نتائج التحليل الإحصائي لاختبار عمليات العلم المؤجل، وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار عمليات العلم ككل بين المجموعات الثلاث. فلقد أظهرت نتائج اختبار ت فروقاً دالة بين نتائج المجموعتين دورة التعلم والتقليدية، لصالح دورة التعلم، كما جاءت النتائج دالة إحصائياً بين نموذج جانييه والتقليدية لصالح نموذج جانييه. كذلك كانت النتائج دالة إحصائياً في اختبار عمليات العلم ككل بين دورة التعلم ونموذج جانييه لصالح دورة التعلم، وهذا يؤكد تفوق دورة التعلم على نموذج جانييه والطريقة التقليدية في عمليات العلم ككل.
وقد تضمن البحث عدداً من التوصيات والمقترحات
مفهوم تعليم القراءة لدى معلمات اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية وواقع تعليمهن القراءة من وجهة نظر المشرفات التربويات
1423 - 1424هـ
أ.مشاعل محمد إبراهيم الفقيه
رسالة ماجستير
قسم التربية وعلم النفس
كليات البنات - كلية التربية
الرياض
موجز البحث :
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم تعليم القراءة لدى معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية, وتشخيص واقع تطبيقهن مفهوم تعليم القراءة من وجهة نظر مشرفات اللغة العربية.من خلال ذلك فإن هذا البحث يحاول الإجابة عن الأسئلة التالية :س: ما مفهوم تعليم القراءة لدى معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية؟
س: ما مدى تطبيق معلمات اللغة العربية في الصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية مفهوم تعليم القراءة من وجهة نظر المشرفات؟س: هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين معرفة المعلمات مكونات مفهوم تعليم القراءة وتطبيقها من وجهة نظر المشرفات؟س: هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين نتائج اختبار مفهوم تعليم القراءة لدى المعلمات وفقًا لمتغيرات الشخصية (المؤهل, الدورات التدريبية, سنوات الخبرة في التدريس, نوع الإعداد)؟س: هل توجد فروق دالة احصائيًا بين آراء مشرفات اللغة العربية حول تطبيق المعلمات مفهوم تعليم القراءة وفقًا لمتغيرات الشخصية (سنوات الخبرة في التدريس, سنوات الخدمة في الإشراف, المؤهل, الدورات التدريبية)؟
وقد استخدمت الباحثة أداتين لجمع معلومات البحث :الأولى : اختبار مفهوم تعليم القراءة لقياس مفهوم تعليم القراءة لدى معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.الثانية: استفتاء يهدف إلى الكشف عن تطبيق معلمات اللغة العربية مفهوم تعليم القراءة من وجهة نظر مشرفات اللغة العربية.وقامت الباحثة بتحليل درجات اختبار المعلمات التي جمعت من (435) معلمة, كما قامت بتحليل استجابات المشرفات التي جمعت من (60) مشرفة مثلن مراكز الإشراف الأربعة بمدينة الرياض.
واستخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية التالية : التكرارات, النسب المئوية, المتوسط الحسابي, الإنحراف المعياري, تحليل التباين الاحادي, اختبار (ت), معامل ارتباط بيرسون, معامل الفاكروبناخ.وقد أسفر البحث عن النتائج التالية :حصلت معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية على متوسط حسابي وقدره (4.12) من أصل (5) في محور معالجة المحتوى,
وهذا يعني أن معلمات اللغة العربية مقتنعات بأهمية معالجة المحتوى أثناء تعليم القراءة, وحصلت معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية على متوسط حسابي وقدره (4.25) في محور معالجة الميول, وهذا يعني أن معلمات اللغة العربية يرون أهمية تنمية الميول القرائية أثناء تعليم القراءة, وحصلت معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية على متوسط حسابي وقدره (4.39) في محور معالجة مهارات القراءة,
وهذا يشير إلى إلمام معلمات اللغة العربية بمهارات القراءة, وحصلت معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية على متوسط حسابي وقدره (4.32) في محور معالجة القراءة على أنها أداة للتواصل, وحصلت معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية على متوسط حسابي وقدره (4.12) في محور معالجة تكامل القراءة مع مواد المنهج الأخرى, وهذا يشير إلى أن غالبية المعلمات واعيات بأهمية تكامل القراءة مع مواد المنهج الأخرى.
أما مستوى تطبيق معلمة للغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية لمحور معالجة المحتوى من وجهة نظر المشرفات قد بلغ متوسط حسابي وقدره (3.45) مما يشير إلى تقيد معلمات اللغة العربية بمحتوى مادة القراءة بدرجة كبيرة, ومستوى تطبيق معلمة اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية لمحور معالجة الميول من وجهة نظر المشرفات قد بلغ متوسط حسابي وقدره (2.24), وهذا يشير إلى الاهتمام بدرجة متوسطة بمراعاة ميول التلميذات أثناء تعليم القراءة, ومستوى تطبيق معلمة اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية لمحور معالجة مهارات القراءة من وجهة نظر المشرفات قد بلغ متوسط حسابي وقدره (2.70),
وهذا يشير إلى الاهتمام المتوسط بمراعاة مهارات القراءة أثناء تعليمها, ومستوى تطبيق معلمة اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية لمحور معالجة القراءة على أنها أداة للتواصل من وجهة نظر المشرفات قد بلغ متوسط حسابي وقدره (2.85), وهذا يشير إلى الاهتمام المتوسط بتطبيق القراءة باعتبارها عملية تواصل, وسمتوى تطبيق معلمة اللغة العربية بالصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية لمحور معالجة تكامل القراءة مع مواد المنهج الأخرى من وجهة نظر المشرفات قد بلغ متوسط حسابي وقدره (2.40), وهذا مما يشير إلى تطبيق المعلمات لمحور التكامل مع المواد الأخرى بدرجة متوسطة أثناء تعليم القراءة.
توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى (0.01) بين معرفة معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا من المرحلة الابتدائية مكونات مفهوم تعليم القراءة وتطبيقها من وجهة نظر مشرفات اللغة العربية لصالح معرفة المعلمات مفهوم تعليم القراءة.لا توجد فروق دالة احصائيًا بين معلمات اللغة العربية بالصفوف العليا من المرحلة الابتدائية في معرفتهن مفهوم تعليم القراءة تبعًا لاختلاف متغيرات الشخصية (الدورات التدريبية, سنوات الخبرة في التدريس, المؤهل, نوع الاعداد).
لا توجد فروق دالة احصائيًا بين آراء مشرفات اللغة العربية حول تطبيق معلمات اللغة العربية مفهوم تعليم القراءة تبعًا لاختلاف متغيرات الشخصية (سنوات الخبرة في التدريس, سنوات الخبرة في الإشراف, الدورات التدريبية, المؤهل).وفي ضوء نتائج البحث توصي الباحثة :بضورة زيادة نشر الوعي حول مفهوم تعليم للقراءة, ومن ثم تعليم القراءة بتطبيق المفهوم الذي يؤكد على الاهتمام بمعالجة المحتوى, ومعالجة والميول, ومعالجة المهارات, ومعالجة القراءة باعتبارها أداة واصل ومعالجة تكامل القراءة مع المواد الأخرى.
وتقترح الباحثة طرح مفهوم تعليم القراءة الشامل ضمن موضوعات مقرر طرق التدريس في كليات إعداد المعلمات وإلمام المعلمة بهذا المفهوم ومن ثم تطبيق هذا المفهوم وإعداد دليل لمعلمة اللغة العربية يشمل الأساليب الحديثة في تدريس القراءة خاصة وفروع اللغة العربية الأخرى, وإعداد محتوى مناسب يراعى فيه جميع مكونات مفهوم تعليم القراءة, وزيادة الوقت المخصص لتعليم القراءة لتتمكن المعلمة من تطبيق كل ما يتعلق بجوانب مفهوم تعليم القراءة,
وإعداد دليل مهارات القراءة وتدريب المعلمات على تحديدها, ومراعاة الفروق الفردية بين التلميذات أثناء تعليم القراءة, وتوجيه مشرفات اللغة العربية إلى ضرورة الأخذ بمكونات مفهوم تعليم القراءة وإدراجها ضمن أسس التقويم التي تقوم المعلمة, وتحديد أهداف تعليم القراءة وتدريب المعلمات على تحقيقها وفقًا لمكونات مفهوم القراءة.
فاعلية برنامج مقترح في الحاسب الآلي لتنمية التفكير الناقد والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 1423هـ،2002م
د.نوال بنت محمد بن عبدالرحمن بن راجح
رسالة دكتوراة
قسم التربية وعلم النفس
كليات البنات - كلية التربية
الرياض
لكل عصر خصائصه التي يتميز بها عن غيره ، حيث يتميز هذا العصر بعدة خصائص منها : التقدم التقني ، والإنفتاح العالمي ، والتقارب الثقافي ، وتدفق المعلومات . وتغدو الحاجة الملحة إلى تعلم مهارات التفكير الناقد لأفراد المجتمع أشد ما تكون في عصرنا الحاضر حتى تكون لديهم نظرة نافذة تمكنهم من تقويم ونقد ما يقرأونه وما يشاهدونه وما يسمعونه . وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب تؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المغرفي الذي يتعلمونه ، ذلك أن التعلم في أساسه عملية تفكير ، وأن توظيف التفكير في التعلم يحول عملية إكتساب المغرفة من غملية خاملة إلى نشاط عقلي يفضي إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي ، وإلى ربط عناصره بعضها ببعض .
وتتحد مشكلة الدراسة في ضعف مهارات التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة الثانوية وإنخفاض مستوى تحصيلهن الدراسي في مادة الرياضيات ومحاولة تقصي أثر فاعلية برنامج في الحاسب الآلي على تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ومستوى تحصيلهن الدراسي في مادة الرياضيات . وبذلك يمكن القول بأن الدراسة تسعى للإجابة عن السؤال التالي : ما فاعلية برنامج مقترح في الحاسب الآلي لتنمية التفكير الناقد والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ؟ .
ويتفرع من السؤال السابق الأسئلة التاليـة :- 1 . ما البرنامج الحاسوبي المقترح لتنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مقرر مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي ؟ 2 . ما أثر هذا البرنامج على تنمية بعض مهارات التفكير الناقد ؟ 3 . ما أثر هذا البرنامج على تنمية التحصيل الدراسي .
أهداف الدراسـة : 1 . تصميم برنامج في الحاسب الآلي في مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي . 2 . دراسة أثر هذا البرنامج على تنمية بعض مهارات التفكير الناقد . 3 . دراسة أثر هذا البرنامج على تنمية التحصيل الدراسي .
أهمية الدراسـة : 1. يستمد البحث أهميته من أهمية الموضوع الذي يتناوله ، التفكير الناقد والحاسب الآلي ، واللذان يعدان مطلباً ملحاً في هذا العصر . 2 . إن نتائج هذه الدراسة قد تفيد : - المهتمين بتدريس الرياضيات ، وتطوير مناهجها ، من حيث جدوى إستخدام تقنيات التعليم في تدريس الرياضيات .
- الموجهات والمعلمات ، وذلك بتتبع مهارات التفكير الناقد ، ودرجة إكتساب طالباتهن لها ، والعمل على تنميتها من خلال المحتوى ، والحاسب الآلي ، والأنشطة التدريسية .
وكان المنهج شبه التجريبي هو المنهج المناسب لطبيعة هذه الدراسة ، حيث يعتمد هذا التصميم على مجموعتين متكافئتين ( تجريبية وضابطة ) فالمجموعة التجريبية درست المحتوى "وحدة هندسة المتجهات" بإستخدام برنامج بوربوينت . أما المجموعة الضابطة فقد درست نفس المحتوى ولكن بدون إستخدام البرنامج . وكان عدد أفراد كل مجموعة 43 طالبة . وأعدت الباحثة إختبار تحصيلي في وحدة هندسة المتجهات وإختبار يقيس التفكير الناقد لدى الطالبات في الرياضيات .
وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي : 1 . تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مستوى التذكر وفي إختبار التحصيل الكلي . 2 . تكافؤ طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في كل من : مستوى الفهم ومستوى التطبيق ومستوى التحليل .
تحديد الحاجات التدريبية لمعلمات رياض الأطفال في مجال المنهج المدرسي
إعــــــــــــــــــداد : الطالبة منى بنت حمد بن على العواد .
إشــــــــراف : الدكتور موافق بن فواز الرويلي .
تلخيص / خالد بن عبد المحسن الطريقي
شمل هذا البحث خمسـة فصول، إضافة إلى الملاحق والمراجع حيث تناول الفصل الأول مدخل البحث، فتضمن المقدمة، وتحديد مشكلة البحث ووضع أهدافها وصياغة أسئلتها وإيضاح أهمية البحث ورسم حدوده وتعريفاً لمصطلحاته وإبرازاً لمنهجه .
فتحددت مشكلة البحث في تحديد الحاجات التدريبية أثناء الخدمة لمعلمات رياض الأطفال في مجال المنهج، والذي يشـمل دراسة الحاجات التدريبية ذات العلاقة بمكونات عناصر المنهج المختلفة وهي : الأهداف، المحتوى، والخبرات التعليمية، والتقويم .
وتم الإجابة عن أسئلة البحث، وذلك لتحقيق أهداف البحث، وتمثلت هذه الأسئلة في التالي :
1. هل هناك حاجات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال تتعلق بأهداف المنهج المدرسي؟
2. هل هناك حاجات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال تتعلق بمحتوى المنهج المدرسي؟
3. هل هناك حاجات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال تتعلق بالخبرات التعليمية التي يشملها المنهج المدرسي؟
4. هل هناك حاجات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال تتعلق بتقويم المنهج المدرسي؟
5. هل هناك فروق في الحاجات التدريبية أثناء الخدمة بين معلمات رياض الأطفال تبعاً للخبرة في التدريس والإعداد الأكاديمي والمؤهل التربوي والجنسية ونوع المدرسة (حكومية أو أهلية) التي يعملن فيها؟
وتبرز أهمية البحث في أنها تساهم في التعرف على حاجات معلمة رياض الأطفال من وجهة نظر المعلمات أنفسهن، وذلك لإعداد برامج تدريبية أفضل تتوافق مع الحاجات التدريبية للمعلمات . وبهذا تعطي هذه الدراسة المسؤولين عن التعليم والتدريب صورة واضحة عن الأمور التي تحتاجها معلمة رياض الأطفال فيما يخص المنهج، لإدخالها ضمن برامج التدريب أثـناء الخدمة لمعلمات رياض الأطفال بغرض جعل برامج التدريب أكثر ملاءمة للحاجات التدريبية .
وشمل البحث معلمات رياض الأطفال اللاتي يعملن في مدارس حكومية واللاتي يعملن في مدارس أهلية، وتم تطبيق هذا البحث في الفصل الدراسـي الأول لعام 1420هـ، وتم تعريف المصطلحات التي استـخدمت في البحث وهي : الحاجات التدريبية ورياض الأطفال والمنهج المدرسي والتدريب أثناء الخدمة . واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لوصف حاجات معلمات رياض الأطفال ومن ثم تحليلها . أما الفصل الثاني، فقد حوى الإطار النظري والدراسات السابقة، وقد تناول الإطار النظري ماهية التدريب أثناء الخدمة، وما لهذا التدريب من أهمية كبيرة على المعلم والعمليـة التعليمية ككل حيث تضمن الأسباب التي دعت إلى ضرورة التدريب أثناء الخدمة، ومن ثم تناول هذا الفصل أهداف التدريب أثناء الخدمة والبرامج التدريبية ومالها من أنواع عديدة، وأيضا الأساليب التدريبية المتعددة لعرض البرامج التدريبية، وكذلك الحاجات التدريبية وتعريفاتها، وأنواع تحديد هذه الحاجات، والخطوات المتبعة عند تصميم برنامج لتدريب المعلمين أثناء الخدمة، ومصادر التعرف على الحاجات التدريبية . ثم تلا ذلك الحاجة إلى تدريب العاملين في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية وتضمن دواعي التدريب أثناء الخدمة بشكل عام، وما تضمنه من قصور في الإعداد السابق للمعلمين وعدم الاعتماد على خبرات المعلم الســابقة، واشتمل على بعض الدراسـات التي أجريت في هذا المجال، ومن ثم يأتي التأكيد على حاجات معلمات رياض الأطفال ودواعي التدريب أثناء الخدمة لما فيه من أهمية لهن في هذه المرحلة وما يجب أن تتميز به معلمة رياض الأطفال مهنياً وشخصياً والتنامي السريع في أعداد مدارس رياض الأطفال وبالتالي زيادة في عدد معلمات رياض الأطفال، وكذلك القصور في برامج إعداد معلمات رياض الأطفال، ومن ثم الوقوف على المشكلات التي تواجه أجهزة التدريب، ثم عرض لعدد من الدراسات السابقة التي لها علاقة بالحاجة للتدريب أثناء الخدمة في عناصر المنهج من الأهداف والمحتوى والخبرات التعليمية والتقويم .
أما الفصل الثالث فشمل إجراءات البحث، وهي : مجتمع البحث وعينة البحث، والأداة المستخدمة في البحث، وعرض للمعالجة الإحصائية المستخدمة في البحث، والتأكد من الصدق الإحصائي والثبات للأداة ومناقشة كيفية تطبيق الاستفتاء على معلمات رياض الأطفال . ويحتوي الفصل الرابع على وصف عينة البحث وعرض وتحليل وتفسير لنتائجه حيث تضمن الإجابة عن أسـئلة البحث التي أظهرت مدى حاجة معلمات رياض الأطفال للتدريب أثناء الخدمة على عناصر المنهج المدرسي : الأهداف، والمحتوى، والخبرات التعليمية والتقويم .
وتناول الفصل الخامس خلاصة البحث وأهم النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات .
نتائج البحث :
1. إن حاجة معلمات رياض الأطفال للتدريب أثناء الخدمة في مجال الأهداف هي حاجة متوسطة، حيث كانت العناصر ذات الأولوية في الحاجات لدى معلمة رياض الأطفال في مجال الأهداف هي :مرونة الأهداف التعليمية (متجددة)، واســـتمرارية الأهداف التعليمية، وواقعية الأهداف التعليمية (معرفي، وجداني، نفس حركي) . أما أقل العناصر حاجة لدى المعلمات فهي الأهداف العامة للتعليم، ووضوح الأهداف التعليمية والأهداف العامة لرياض الأطفال .
2. أما حاجة معلمات رياض الأطفال للتدريب أثناء الخدمة في مجال المحتوى فهي حاجة متوسطة، وكانت العناصر ذات الأولوية حسب الحاجة هي الصدق العلمي للمحتوى، والتنظيم السيكولوجي (النفسي) لمحتوى الوحدات التعليمية، والتنظيم المنطقي لمحتوى الوحدات التعليمية (من البسيط للمركب) وتنوع المحتوى، أما أقل العناصر حاجة لدى المعلمات فهي محتوى الوحدات التعليمية والوقت المتاح للتعلم وقابلية المحتوى للتعلم .
3. أما حاجة معلمات رياض الأطفال للتدريب أثناء الخدمة في مجال الخبرات التعليمية فيظهر عنصر واحد في نطاق الحاجة الماسة وهو الخبرات التعليمية وإشباع ميول الأطفال، أما بقية العناصر فهي تقع في نطاق الحاجة المتوسطة لدى المعلمات، وتتمثل العناصر ذات الأولوية في الحاجة لدى معلمات رياض الأطفال في الخبرات التعليمية وإشباع ميول الأطفال، وطرق التدريس والإمكانات المتاحة في الروضة وطرق التدريس، وملاءمتها لقدرات الأطفال، الخبرات التعليمية واستمرارها، ومراعاة الفروق الفردية، أم أقل العناصر حاجة لدى المعلمات فهي تتابع الخبرات التعليمية والخبرات التعليمية وتنمية مهارات الاتصال وصدق الخبرات التعليمية .
4. أما حاجة معلمات رياض الأطفال للتدريب أثناء الخدمة في مجال التقويم فهي تمثل حاجة متوسطة وكانت العناصر ذات الأولوية في الحاجة لدى المعلمات هي تقويم مدى مراعاة الأهداف لمستويات النمو، تقويم محتوى الوحدات التعليمية، تقويم الأهداف التعليمية لمرحلة رياض الأطفال، وتقويم أدوات التقويم، وتقويم الأنشطة التعليمية، أما أقل العناصر حاجة لدى المعلمات فهي تقويم الأهداف العامة للتعليم، وتقويم الأهداف التعليمية للوحدات التعليمية .
5. إن معظم المتوسطات الحسابية المتعلقة بالأهداف والمحتوى والخبرات التعليمية والتقويم تقع بين الدرجة الرقمية (1.67) و (2.33) وهي تمثل الحاجة المتوسطة، عدا عنصر واحد في مجال الخبرات التعليمية، تقع بين الدرجة الرقمية (2.34) و (3.00) وهي تمثل الحاجة الماسة، ويتعلق ذلك بعنصر الخبرات التعليمية وإشباع ميول الأطفال .
6. يوجد اتفاق في آراء معلمات رياض الأطفال حول مدى الحاجة للتدريب على عناصر المنهج المدرسي باختلاف سنوات خبراتهن، وذلك لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء معلمات رياض الأطفال على اختلاف سنوات خبراتهن في التعليم في رياض الأطفال حول مدى الحاجة للتدريب على عناصر المنهج لأن قيمة (ف) لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية عند (0.05) .
7. يوجد اختلاف بين آراء معلمات رياض الأطفال حول مدى الحاجة للتدريب على عناصر المنهج باختلاف مؤهلاتهن العلمية، وذلك لوجود فروق لصالح معلمات رياض الأطفال الحاصلات على مؤهل (الثانوية العامة والحاصلات على مؤهل المعهد الثانوي) عن بقية آراء المعلمات بجميع فئات مؤهلاتهن المختلفة، لأن قيمة (ت) دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) .
8. يوجد اتفاق في آراء معلمات رياض الأطفال على اختلاف مؤهلاتهن التربوية حول مدى الحاجة للتدريب في جميع محاور الدراسة الأربعة، وذلك لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء معلمات رياض الأطفال على الرغم من اختلاف مؤهلهن التربوي، لأن قيمة (ت) غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) في جميع محاور الدراسة.
9. يوجد اتفاق في جميع آراء معلمات رياض الأطفال على الرغم من اختلاف جنسياتهن (السعوديات وغير السعوديات) حول مدى الحاجة للتدريب في جميع محاور الدراسة الأربعة، وذلك لوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء معلمات رياض الأطفال تبعاً لاختلاف جنسياتهن، وذلك لأن قيمة (ت) لم تكن دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) في جميع محاور الدراسة .
10. يوجد اتفاق في آراء معلمات رياض الأطفال على الرغم من اختلاف نوع المدرسة (حكومية أو أهلية) اللاتي يعملن بها حول مدى الحاجة للتدريب على الحاجات في جميع محاور الدراسة الأربعة، وذلك لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء معلمات رياض الأطفال تبعا لاختلاف نوع المدرسة التي يعملن بها (حكومية أو أهلية) لأن قيمة (ت) لم تكن دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) .
فاعلية برنامج مقترح في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني لدى الطالبات المعلمات بقسم الدراسات الإسلاميةبكليات التربية للبنات
1425هـ - 2004م
د.نهى بنت محمد الملا
رسالة دكتوراة
قسم التربية وعلم النفس
كليات البنات - كلية التربية
الرياض
هدف هذا البحث استقصاء فاعلية برنامج مقترح في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني لدى الطالبات المعلمات بقسم الدراسات الإسلامية بكليات التربية للبنات وهذه الكفايات هي: كفايات معرفية، كفايات مهارية، كفايات وجدانية.ولقد استخدم في هذا البحث التصميم التجريبي المعروف بتصميم المجموعة الضابطة ذات الاختبار البعدي فقط عشوائية الاختيار.
Randomized Post-Test only Control Group Design
وشملت عينة البحث (50) طالبة معلمة في الفرقة الثالثة قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، تم اختيارهن بطريقة عشوائية، ووزعن في مجموعتين: أحداهما تجريبية وعددها (25) طالبة، والأخرى ضابطة وعددها (25) طالبة، وقد طبق البرنامج على المجموعة التجريبية بينما لم يطبق على المجموعة الضابطة أي إجراء تجريبـي.
ولقياس الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في كل من : التحصيل الدراسي عن التعلم التعاوني، المهارات الأدائية الخاصة بالتخطيط، والتنفيذ والتحضير والتقويم باستراتيجية التعلم التعاوني، والاتجاه نحو التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني.أعدت الباحثة اختبارًا تحصيليًا ، وبطارية تقويم مهارات التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني وتضمنت:§ بطاقة ملاحظة لأداء الطالبة المعلمة في التخطيط لدرس بالتعلم التعاوني.§ بطاقة ملاحظة لأداء الطالبة المعلمة في تنفيذ إجراءات الدرس بالتعلم التعاوني.
§ بطاقة ملاحظة لأداء الطالبة المعلمة في تحضير البيئة المادية (الفيزيقية) للتدريس بالتعلم التعاوني.§ بطاقة ملاحظة لأداء الطالبة المعلمة في تنفيذ أساليب تقويم تعلم التلميذات بالتعلم التعاوني.كما أعدت مقياسًا للاتجاه نحو التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني، وطبقت الأدوات البحثية بعديًا -بعد انتهاء البرنامج التدريبـي- على أفراد المجموعتين.
وبعد الحصول على البيانات الناتجة عن القياس البعدي تم تنظيمها، ثم معالجتها إحصائيًا باستخدام اختبار "ت" t-test للتحقق من الدلالة الإحصائية للفرق بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية ، والضابطة. كما تم استخدام أحد مقاييس حجم التأثير المعروف باسم مربع إيتا (h2) لمعرفة فاعلية البرنامج المقترح على المتغيرات التابعة. ولقد أسفرت نتائج البحث عن ما يلي:
1- وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي عن التعلم التعاوني، وذلك لصالح المجموعـة التجريبيـة، كما بلغـت قيمة مربـع إتيـا (93.20%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
2- وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات الأدائية الخاصة بالتخطيط والتنفيذ والتحضير والتقويم باستراتيجية التعلم التعاوني، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، كما بلغت قيمة مربع إيتا (88.46%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
ويتصل بهذه النتيجة النتائج التالية:
1-2 وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى ? 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة تخطيط الدروس باستراتيجية التعلم التعاوني وذلك لصالح المجموعة التجريبية، كما بلغت قيمـة مربـع إيتـا (68.37%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
2-2 وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى ? 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة تنفيذ إجراءات الدرس باستراتيجية التعلم التعاوني وذلك لصالح المجموعة التجريبية، كما بلغت قيمة مربع إيتا (85.18%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
3-2 وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى ? 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة تحضير البيئة المادية (الفيزيقية) للتدريس باستراتيجية التعلم التعاوني ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، كما بلغت قيمة مربع إيتا (92.05%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
4-2 وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة تنفيذ أساليب تقويم تعلم التلميذات باستراتيجية التعلم التعاوني، وذلك لصالح المجموعة التجريبية كما بلغت قيمة مربع إيتا (88.17%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
3- وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في الاتجاه نحو التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني، وذلك لصالح المجموعة التجريبية ، كما بلغت قيمة مربـع إيتـا (52.75%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
4- وجود فرق ذي دلالة إحصائية (عند مستوى 0.05) بين متوسطي الأداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في مجموع الكفايات الكلية للتدريس باستراتيجية التعلم التعاوني وذلك لصالح المجموعة التجريبية، كما بلغت قيمة مربع إيتا (90.78%) وهي نسبة مرتفعة التأثير تبين ما للبرنامج من أثر في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني.
وفي ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج قدمت الباحثة عددًا من التوصيات التي يمكن الأخذ بها في برامج إعداد وتربية المعلمات في المملكة العربية السعودية سواء لإعدادهن قبل الخدمة أم لتدريبهن أثنائها ومن بينها:
- ادراج موضوع كفايات التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني ضمن الخطة الدراسية لمقررات طرق التدريس بكليات التربية للبنات بصفة عامة، ومقررات طرق التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بصفة خاص
أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس التاريخ على تنمية التفكير الابتكاري لدى طلاب الصف الأول الثانوي بسلطنة عمان
إعداد/ محمد بن طالب بن مسلم الكيومي
رسالة ماجستير من كلية التربية - جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان
مشكلة الدراسة وإطارها النظري
يعد التفكير الابتكاري من أهم القدرات التي يجب على الأنظمة التربوية توجيه عناية خاصة بها لكي تجيد هذه الأنظمة أداء الدور المنوط بها في عالم اليوم، هذا العالم الذي يتميز بكثرة التحديات والمشكلات التي يعايشها الأفراد والمجتمعات، وازدياد حدة التنافس والصراع بين الدول من أجل البقاء واثبات الوجود.
وهنا يجب على الأنظمة التربوية صوغ توجهات مستقبلية في مناهجها التربوية وأهمها التخلي عن السياسات التعليمية القائمة على اكساب المعلومات وتخزينها في عقول المتعلمين والتوجه نحو تنمية قدرات التفكير عند الطلاب.
ومادة الدراسات الاجتماعية من المواد التي يرتكز عليها أي نظام تربوي في كل بلاد العالم، وهي إذا ما أحسن الإعداد لها وتدريسها تعد ميداناً خصباً لتنمية التفكير عند الطلاب . والتاريخ يعد مجالاً واسعاً لاثارة التفكير واطلاق العنان للخيال مما يشجع على التفكير الابتكاري، وقد أشار هدسون إلى أن التاريخ ميدان خصب للتفكير التباعدي.
وعلى الرغم من تأكيد أهداف تدريس التاريخ في المرحلة الثانوية بسلطنة عمان على اكتساب مهارات التفكير الإبتكاري كالبحث والاستقصاء مع استخدام الأسلوب العلمي في التفكير، وإجراء مختلف العمليات العقلية عليها مع توفير موقف تعليمي يسمح للطلاب بالمبادأة وطرح أسئلتهم وتقبل مشاعرهم وتقدير الاجابات. إلا أن الواقع الفعلي لتدريس هذه المادة يركز على إكساب الطلاب الكم الهائل من المعلومات التي تزدحم بها الكتب المدرسية، مما أدى بالمعلمين إلى اعتماد طريقة التدريس التقليدية المتمثلة في التلقين لنقل تلك المعلومات إلى أذهان الطلاب بالرغم من الضعف الذي أظهرته في تنمية التفكير.
وهناك الكثير من الطرق والاستراتيجيات والأساليب والبرامج الموجهة لتنمية التفكير الابتكاري ومن أهمها استراتيجية العصف الذهني؛ كونها جربت في الميدان التربوي على العديد من المواد التعليمية وأثبتت فعاليتها في تنمية قدرات الابتكار لدى الطلاب. ومن هنا تاتي هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس التاريخ على تنمية قدرات الابتكار لدى طلاب الصف الأول الثانوي بالسلطنة. كون الباحث لم يعثر على دراسة استخدمت العصف الذهني لتنمية التفكير الابتكاري في مادة التاريخ.
ولكن ما هو التفكير الأبتكاري؟
التفكير الابتكاري
عرف الباحث التفكير الابتكاري بانه عملية نفسية عقلية يمارس الفرد خلالها تفكير انفراجي حر على مشكلة محددة بهدف الوصول إلى حلول جديدة ومثيرة لدهشة الآخرين. والتفكير الابتكاري هو أحد أنواع التفكير التباعدي والذي يعني التفكير في نسق مفتوح موجه لاعطاء حلول متنوعة للمشكلة.
لذا أن أبرز ما يميز التفكير الابتكاري هو التغيير، فعند مواجهة مشكلة ما يجب تجنب الأفكار المسيطرة أو المهيمنة دائما، بل يبدأ البحث عن بدائل، أفكار جديدة، مقترحات متنوعة وهنا يعد التفكير الابتكاري مدخل جديد في النظر للمشكلة يختلف عن المداخل التقليدية، وهو مدخل تطويري تغييري للأفضل، وقد أطلق عليه ديبونو التفكير الجانبي لأنه كما ذكر يأخذ مساراً آخر في العقل غير المسار النمطي التقليدي المقيد.
وتتطلب عملية التفكير الابتكاري قبل كل ذلك تحديداً دقيقاً للمشكلة حتى يمكن التركيز عليها وضخ أفكار عميقة وموجهة بعناية، أما المشكلة التي يعنى التفكير الابتكاري بايجاد حلول لها فتعني الشيئ المتضمن في موقف أو قضية ما ونريد ايجاد حلول له حتى يمكننا التطوير والتغيير، أي الانتقال بالموقف من حالة راهنة إلى حالة أفضل.
ويتطلب التفكير الإبتكاري عدة قدرات خاصة وهي :
1- الحساسية للمشكلات (Sensitivity to problems): وتعني القدرة على رؤية العيوب والاحتياجات والنقائص في المعرفة.
2- الطلاقة (Fluency): وتعني القدرة على إنتاج أكبر عدد من الاستجابات المرتبطة بالموضوع.
3- المرونة (Flexibility): وهي القدرة على توجيه أو تحويل مسار التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقف وهي عكس الجمود الذهني.
4- الأصالة (Originality): وتعني القدرة على إنتاج استجابات غير عامة، بعيدة، غير
عادية وذات ارتباطات غير تقليدية. والأصالة تعتبر أكثر وجه يعكس التفكير الإبتكاري.
ولتنمية التفكير الابتكاري للطلاب في المدارس العديد من الفوائد التربوية أهمها:
- حل المشكلة: حيث يتخرج الطالب من المدرسة ولديه القدرة على حل المشكلات بطريقة علمية وبجدة مستخدماً أنماط تفكير جديدة وغير روتينية.
- الصحة العقلية: أثبت ماسلو أن ممارسة التفكير الابتكاري يولد صحة عقلية عند الطالب، لأن التفكير الابتكاري يتيح للطالب فرصة التعبير عن أفكاره بحرية وبدون نقد، كما يشعر بأنه هو الذي يولد المعرفة وينتجها.
- تقدير الذات: يتيح التفكير الابتكاري للطالب إعطاء حلول مختلفة للمشكلة بحرية، ويتقبل المعلم كل تلك الحلول ولا ينقدها إلا في النهاية، لذا يعد ذلك تعزيزاً للطالب مما يعزز صورة الذات لديه.
- الاختراع: هناك علاقة وثيقة بين التفكير الابتكاري وتطوير القدرة الاختراعية عند الطالب.
- تقليل العدوانية: عند ممارسة التفكير الابتكاري ستتولد علاقة قوية بين المعلم والطلاب لأنهم سيتشاركون في حل مشكلة ما، ويتقبل المعلم حلول الطلاب قبل نقدها، كما أن العمل على حل مشاكل حيايتة تمس الطالب تجعله يشعر بقيمة التعلم ويقدر هذه العملية؛ وهذايعدل ايجاباً من اتجاهه للمدرسة واحترامه للنظام المدرسي.
- العفوية: التفكير الابتكاري يخلق أفراداً يتسمون بالعفوية والتلقائية وعدم التعقيد والتشدد في المواقف، لأن ممارسة التفكير الابتكاري تجعل الطالب منفتحاً على مختلف البدائل ووجهات النظر.
تنمية التفكير الابتكاري
يتفق علماء النفس أن كل الأفراد الأسوياء لديهم قدرات ابتكارية، لكنهم يختلفون في مستويات امتلاكهم لها. وإذا ما أريد تنمية التفكير الابتكاري فيجب أولاً تهيئة بيئة فصلية محفزة للابتكار يشعر الطا

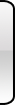

 ملخصات لرسائل علمية في التربية و علم النفس و علم الاجتماع
ملخصات لرسائل علمية في التربية و علم النفس و علم الاجتماع 


